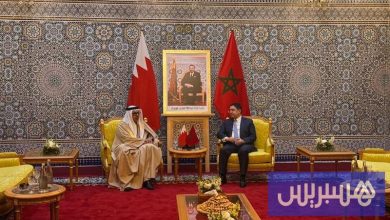الموناليزا.. رحلة ابتسامة تتحدى القرون من فلورنسا إلى ذاكرة العالم

وجهٌ لا يشيخُ، أسئلة أمام الموناليزا..
لماذا هذا الحديث عن الموناليزا؟ أ لأنها اللوحة الأكثر شهرة في العالم، أم لأنها الأكثر غموضًا، أم لأنها الوحيدة التي نجحت في جعل الصمت أكثر بلاغة من الكلام؟ لماذا يظلّ وجهها حاضرًا في المخيلة الإنسانية كما لو كان كوكبًا لا يكف عن الدوران؟ هل لأن ابتسامتها نصف اعتراف ونصف إنكار، أم لأن نظرتها تسائلنا أكثر مما نُسائلها؟ أهو سرّ يدها المستقرة في وقار، أم غياب حاجبيْها، أم الفضاء الخلفي الذي لا ينتهي؟ هل الموناليزا مرآة لزمن عصر النهضة، أم مرآة لنا نحن، لكل لحظة دهشة وحيرة نختبرها أمام لغز الحياة؟.
ابْتسامةٌ تتحَدّى القُرون
في لحظة عابرة جلستُ أمام الموناليزا، ووجدت اللوحة وكأنها بوابة إلى عالمٍ موازٍ حيث الزمن يتفتّت وتتداخل الصّور والأفكار. لم تكن مجرد وجهٍ مبتسم، كانت تجسيدًا للغموض الذي يختبئ في كل إنسان، بين ما يُقال وما يظلّ صامتًا. شعرتُ بأن اللّوحة تنظر إليّ كما أنني أنظر إليها، وبأنّ هُناك حوارًا غير مرئي بين الروح والفن، حيث يختفي المكان ويصبح التأمل امتدادًا للوعي نفسه، رحلة في دائرة لا تنتهي من السّؤال والدّهشة، من الإدراك والخيال.
في مطلع القرن السادس عشر، وبين جدران مُحترفٍ مُتواضع في فلورنسا، جلس ليوناردو دافنشي يرسم امرأة غامضة تدعى “ليزا غيرارديني”؛ لم يكن يدرك آنذاك أنّ تلك الابتسامة الموشومة على وجهها العابر ستغدو أيقونة خالدة، وأنّ هذا العمل سيُعاد تأويله بوصفه “نصًّا بصريًّا” يفيض بالدلالات ويتجاوز حدود الزمن. سنوات طويلة استغرقها دافنشي في إتمام اللوحة، مصطحبًا إيّاها معه في تنقّلاته حتى استقرّت في فرنسا، حيث وجدت مأواها الأخير في أروقة متحف اللّوفر. ومنذ ذلك الحين تحوّلت الموناليزا من لوحة فنية إلى قطعة من الذاكرة الإنسانية، تُقرأ كما تُقرأ الأساطير، وتُستحضر كما تُستحضر الرموز الكبرى التي تصوغ وعي الحضارة.
غير أنّ سرّ الموناليزا لا يكمن في تقنيتها وحدها، وإنما في ذلك الفائض من الغموض الذي يلفّ ابتسامتها كلما شاهدها المتلقي؛ إنّها ابتسامة تتأرجح بين الحضور والغياب، بين الرضا والشك، في تعبيرها عن معادلة جمالية وفكرية تجعل اللّوحة أشبه بمرايا متعدّدة، يرى فيها كل جيل انعكاس قلقه الخاص. لقد استطاعت هذه الابتسامة أن تحوّل اللوحة من صورة لشخص بعينه إلى نصّ يتخطى حدود الكينونة والهوية الفردية. ولعلّ ما يثير الدهشة أنّ الموناليزا لم تُقرأ يومًا بمعزل عن فكرة السرّ؛ فهي دعوة مفتوحة للتأويل، سواء من خلال الدراسات الفنية التي تفكك بنية المنظور والظلّ والنور، أو عبر التأملات الفلسفية التي ترى فيها تمثيلًا لأعمق ما في الروح البشرية من تناقض وتوتر. إنها، بهذا المعنى، تجربة وجودية تحيا مع كل نظرة جديدة، كأنها تحتفظ بقدرة سرمدية على إعادة ابتكار ذاتها في أعين مشاهديها.
نصف ابتسامة، نصف لغز
بهذا المعنى ليست “سيمياء الابتسامة” مجرد قراءة لشكلٍ عابر على الشفتين، إنها تفكيك لمعادلة العلامة في أعمق مستوياتها. فالابتسامة التي لا تكشف عن نفسها كاملة هي قلب السر، ذلك التوتر الغامض الذي يتولد من نصف حضور ونصف غياب. نصف ابتسامة، نصف لغز، لتتحول إلى فضاءٍ يتأرجح بين البوح والكتمان؛ إنّها تُحيل في الآن نفسه على الفرح والهدوء، لكنها تترك وراءها أثرًا من حزنٍ دفين أو تردّد لا يهدأ.
غير أنّ هذه المسافة لا تنتمي إلى اللوحة وحدها، وإنما إلى كل خطاب بصري ينفتح على التأويل. هكذا تحوّلت ابتسامة الموناليزا إلى نموذج لما يمكن أن تفعله العلامة حين تتجاوز حدود وظيفتها المباشرة، فتصبح مجالًا للالتباس البنّاء.
والأهم من ذلك أن هذه العلامة تُدخلنا إلى ما يمكن تسميتها “ميتافيزيقا الابتسامة”: وهي بنية رمزية متجذرة في تجربة الوجود، ابتسامة تتردّد بين الداخل والخارج، بين الصمت والبوح، بين لحظة الزوال والرغبة في البقاء. وهنا بالذات تكمن عبقرية الموناليزا: لقد حوّلت فعل الابتسام من حدث نفسي بسيط إلى نص بصري تتنازعه القراءات، نصّ يذكّرنا بأن أقوى العلامات هي التي تستفز العقل وتؤجج الخيال.
العينان في الموناليزا مركز ثقل النص البصري، والمرايا التي يتكثّف فيها الصمت ويتحوّل إلى خطاب. تلك النظرة التي تتابعك أينما وقفت ليست مجرد خدعة بصرية من نتاج براعة المنظور عند دافنشي، إنها بعدٌ رمزي مُتعمد يقول للمشاهد: “أنا أراك، لكنك لا تستطيع أن تراني كاملة”.
ولأنّ العينين تنفتحان على اللانهائي فإنهما تمنحان الموناليزا سلطة غامضة تراقب وتستجوب، لتضع المشاهد في موقع من يُسأل أكثر مما يَسأل. هنا ينعكس مفهوم الصمت في أبهى تجلياته؛ فالعينان لا تنطقان، لكنهما تحفران في وعي الناظر أثرًا غير قابل للمحْو، كأنهما تدعوانه إلى إعادة صياغة علاقته بالحضور والغياب، بالمعرفة والجهل، بالانكشاف والسّتر؛ إنّهما نصّان صامتان، لكنهما يُنتجان خطابًا أشد وقعًا من الكلام.
ولعلّ المدهش أنّ هذه النظرة المستمرة تتجاوز اللوحة ذاتها لتلامس فكرة “المشاركة الجمالية” في أوسع معانيها.
فالمشاهد، وهو يواجه العينين، يجد نفسه مضطرًا للقبول بجدلية الانعكاس: إنك حين ترى الموناليزا فإنها، في المقابل، تُعيد تشكيلك باعتبارك جزءًا من خطابها. تصبح أنت العلامة، وتتحول التجربة الجمالية إلى علاقة متبادلة من الترجمة الصامتة بين عينين مرسومتين وأعين حيّة تبحث عن المعنى. على أن غياب الحاجبين في الموناليزا ليس تفصيلًا ثانويًا يمكن تجاوزه، إنه في المقابل عنصر يثير في كل مشاهدة سؤالًا مضاعفًا: أهو خطأ الزمن والترميمات المتتالية أم خيارٌ جمالي قصده دافنشي ليُبقي الوجه في منطقة ملتبسة بين الاكتمال والنقصان؟.
الحاجب علامة ذات وظيفة دلالية في التعبير عن الانفعال، وغيابه في الموناليزا ينزع عن الوجه قدرًا من الانفعال المباشر، ويجرده من إشاراته المألوفة، فيدفع المتلقي إلى الغرق في غموض الابتسامة والعينين. وإذا تأملنا هذا الغياب من منظور فلسفي بدا وكأنه يشي بإستراتيجية أعمق: فالموناليزا ليست مجرد صورة لامرأة بعينها، إنها نصّ بصري يتجاوز حدود المحاكاة ليخاطب فكرة الجمال الملتبس والمراوغ. لا يكتفي غياب الحاجبين بتحرير الوجه من الانتماء إلى زمن محدد أو هوية ضيقة، بقدر ما يمنحه طابعًا كونيًا، يتخطى الفردية ليصل إلى المجرد العام؛ وكأن دافنشي قصد أن يخَلّدَ في اللّوحة أثر النّقص، ليظلّ النص مفتوحًا على استكمال لا يتحقق، معلّقًا في فضاء الغموض والسر الذي لا يُكتشف، حيث يظل المشاهد محاصرًا بين الرغبة في الفهم وحدود الإدراك.
على أن الفضاء الخلفي في الموناليزا نصّ موازٍ يضاعف من أثر الغموض الذي يسكن اللوحة، فخلفيتها تكشف عن منظر طبيعي جبلي وساحر، كأنه مشهد متخيَّل يفتح الأفق على اللانهاية، وعلى التيه. بهذا تصبح الموناليزا وكأنها جالسة على تخوم عالمين: عالم الإنسان المحدود في جسده وملامحه وعالم الطبيعة التي تمتد بلا حدود، لتُدخلنا في مفارقة بصرية لا تنفصل عن جوهر اللوحة. بهذا المعنى لا يمكن قراءة الموناليزا من دون قراءة فضائها، لأن الخلفية تمنح الوجه دلالته الوجودية الكبرى: أن الإنسان ليس سوى نقطة صغيرة في محيط كوني لا نهائي. تكمن المفارقة الجمالية في أن دافنشي صوّر هذا الفضاء كما لو كان عالَمًا مفتوحًا وغير مكتمل، تتقاطع فيه المشاهد بانكسارات غير مألوفة للعين، وكأنها تتجاوز قواعد المنظور الواقعي. وهذا التوتر بين الواقعي والمتخيّل، بين المحدود واللامحدود، يمنح لوحة الموناليزا فرادتها، فهي امرأة جالسة أمام مشهد طبيعي، لكنها في الوقت نفسه رمز إنساني يتأمل فضاءً يتعدى حدود الفهم والإحاطة. من هنا يتحقق الشرط الفلسفي للّوحة: إنها تضع الإنسان في مواجهة الأفق الكوني، حيث الجسد يظل محدودًا، لكن النظرة والابتسامة والفراغ المُمتد خلفهما تحيل على اللامتناهي الذي يظل عصيًا على الامْتلاك.
الجسد في الموناليزا ليس حاضرًا كما اعتدنا في صور البورتريه الكلاسيكية، إنه جسدٌ متوارٍ خلف الطاولة، لا تظهر منه إلا اليدان المستريحتان في هدوء مطلق، دليلا على الوقار والصَّمت، يجعل الوجه مركز الثّقل الذي تتكثف فيه كل طاقات المعنى. هنا تتجلّى عبقرية “تقنية التقليل”: فحين يختفي مُعظم الجسد تتضخم السّلطة الرمزية للوجه، ويُختزل الكيان في نظرة وابتسامة وإيماءة صغيرة لليديْن. يسمح هذا التلاشي المتعمد للجسد بتحرير اللوحة من الالتزام بالمقاربة الواقعية المباشرة، ليحوّلها إلى مستوى رمزي أعمق وأكثر إشعاعًا. فالجسد، الذي غالبًا ما يجسد الهوية وينقل العاطفة، يغيب لصالح حُضور الوجه بوصفه نصًا بصريًا مركزيًا، حيث تتكثف المعاني وتتقاطع الدلالات، ليصبح الوجه محورًا لتجربة المشاهدة، وفضاءً لاستدعاء الغموض، والتأمل في العلاقة بين الكينونة والجمال، بين الحضور والغياب. بهذا يصبح جسد الموناليزا “جسدًا مؤجلًا”، غائبًا كي يمنح للوجه قوته المطلقة، وحاضرًا في الوقت نفسه عبر تلك الإشارة الهادئة التي تمنح اللوحة توازنها الرمزي.
حين يختبئ الجمال خلف الغبار
منذ أكثر من خمسة قرون والموناليزا اخبار السعودية ابتسامتها التي لا تشيخ، ابتسامة لغزٍ يواجه كل عينٍ تحدّق فيها. ملايين الزوّار يعبرون أمامها كل عام في أروقة اللوفر، يتأملون تلك النظرة الملتبسة والشفتين المحيّرتين، لكن قلّة فقط من يتوقفون أمام السؤال الأكثر إرباكًا: هل اللوحة التي نراها اليوم هي فعلًا الموناليزا التي رسمها دافنشي، أم إننا أمام نسخة مثقلة بالغبار و”الورنيش” المتآكل؟ لقد أكد العديد من الباحثين أن سطح اللوحة يرزح تحت طبقات من “الورنيش” القديم الذي أصابه الزمن باصفرار قاتم، وأن ألوانها لم تعد بالصفاء والحدة اللذين خرجا من فرشاة ليوناردو. حتى الابتسامة التي أربكت التاريخ قد تكون في أصلها أكثر إشراقًا مما نراه. ومع ذلك فإن تنظيفها ليس قرارًا تقنيًا بريئًا، إنه مغامرة وُجودية: ضربة فرشاة واحدة في عملية الترميم قد تمحو ابتسامة صمدت خمسة قرون. الجدل قائم منذ عقود؛ هناك من يرى أن تركها على حالها أكثر صدقًا، لأن اللوحة أضحتْ وثيقة زمنية مشبعة بأثر القرون: دخان الشموع، غبار المتاحف، وأنفاس ملايين الزائرين الذين مرّوا أمامها. بهذا المعنى فإن كل ذرة غبار هي جزء من سردية اللوحة، وكل طبقة “ورنيش” هي أثرٌ لتاريخ طويل أضحى جزءا من غموضها. في المقابل يصرّ آخرون على أن إعادة تنظيفها قد تكشف “موناليزا أخرى”، أكثر شبابًا وحياة، وربما أكثر غموضًا، كأنها كائن ينهض من تحت الركام ليستعيد بريقه الأول. وهكذا تتحوّل لوحة صغيرة إلى سؤال فلسفي كبير: هل الجمال يكمن في صفائه الأول، أم في ندوبه وآثاره؟ هل نريد أن نرى الموناليزا كما أرادها دافنشي، أم كما أرادها التاريخ؟.
غير أن المفارقة تكمن في أن الجواب نفسه يظل معلّقًا في ابتسامتها؛ فهي تحتضن التناقض وتعيد صياغته: كأنها تقول إن الجمال الحقيقي ليس في النقاء المطلق ولا في التشويه التام، وإنما في الحوار المستمر بين الاثنين. وبهذا تحولت الموناليزا إلى نصّ بصري يعكس جدلية الذاكرة واللحظة، الماضي والحاضر، الأصل والأثر؛ وربما هذا هو الدَّرْس الذي أراده سَيِّدُ عصْر النهضة: أن الجمال لا يكمن في وضوحه، وإنما في غموضه الذي يظل يحجب الحقيقة إلى الأبد.
ماذا تبقى بعد كل هذا؟
هل الموناليزا لوحة، أم سؤال مؤجل؟ هل هي ابتسامة امرأة مجهولة، أم ابتسامة البشرية وهي تواجه سرّها الأكبر؟ هل نحبُّها لأنها جَميلة، أم لأنها تفلت دائمًا من قبضتنا، فلا نراها كما هي، وإنما كما نتمنى أن نراها؟ ربما، في النهاية، سرّ الموناليزا كامن في ما تُصرّ على إخفائه، كأنها تقول لنا: سيبقى الغموض أجمل من الجواب.
لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.