مقدمة القصيدة الجاهلية عند حسان بن ثابت رضي الله عنه
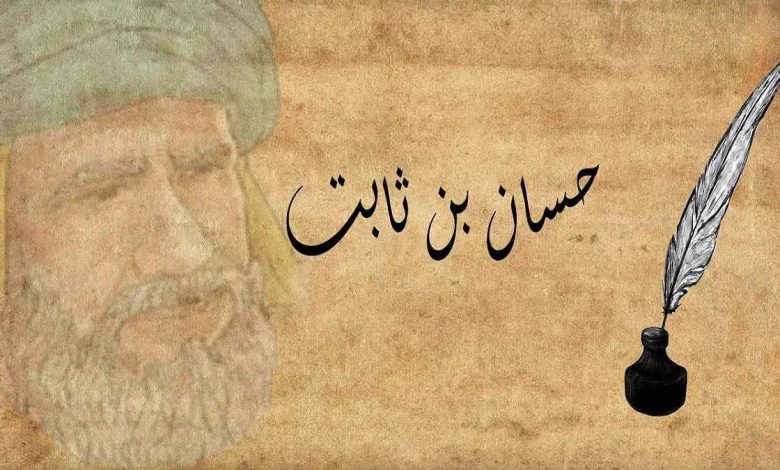
د. محمود عبدالله أبو الخير
أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية جامعة الملك خالد
ملخص البحث
يدرس هذا البحث مقدمة القصيدة الجاهلية عند حسان بن ثابت ؛ فيحاول تفسير تخلي حسان عن المقدمة التقليدية في بعض قصائده ، ثم يلقي الضوء على صور المقدمات في قصائده الجاهلية .
ويتناول مظاهر التطور في تلك المقدمات ؛ فيحدد العناصر والمقومات التي تخلى عنها ، والتي أبقى عليها ، والتي ظهرت في بعض المقدمات ، واختفت في بعضها . ثم يكشف عن العناصر الجديدة في مقدماته الجاهلية ، متمثلة في ميله إلى التركيز والتكثيف ، وفي الاقتصاد في التعبير بالصورة الشعرية ؛ وعن العناصر التي انحرف بها عن منهج السابقين ، متمثلة في تضمين مقدماته ذكر أماكن تقع خارج جزيرة العرب ، واشتمالها على التعبير عن إعجابه بأمجاد الغساسنة ، وبكائه على تلك الأمجاد ، وذكر كرائم إبلهم وخيلهم ، واستعادة ذكرياته في ديارهم ؛ وفي عدم تهافته على المرأة ، أو مخاطرته في سبيل الوصول إليها ، ووصف جواري الغساسنة وتعبيره عن انبهاره بالمرأة الحضرية وزينتها ، وعطرها ، وتفضيلها على البدوية ، ومزج موصوفاته ببعض مظاهر الطبيعة ، واستغلال بعض العناصر الأسطورية في الحياة الجاهلية .
ويناقش البحث خلال ذلك كثيراً من الآراء في مقدمة القصيدة الجاهلية ، وبعض الآراء في الشعر الجاهلي محاولاً تصحيحها .
أثارت مقدمة القصيدة العربية اهتمام النقاد والدارسين ، قدماء ومعاصرين ، من عرب ومستشرقين ؛ فأقبلوا عليها ، معللين ، ومحللين ، ودارسين ؛ وكتبت فيها البحوث ، وألفت فيها الكتب .
وعلى الرغم من ذلك فهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث لتجلية بعض الجوانب ، وتغطية بعض المساحات التي لا تزال بكراً لم ترُدْها الأقدام ، ولم تطأها المناسم .
ومن تلك المساحات مقدمة القصيدة عند حسان بن ثابت ، رضي الله عنه . فعلى الرغم من كثرة ما كتب حول حسان ، فإن حظ الدراسة الفنية منه قليل ، وأقل هذا القليل ما كتب حول مقدمة القصيدة عنده .
ولا شك أن مقدمة القصيدة عند حسان تشكل علامة بارزة في مسيرة مقدمة القصيدة العربية ، ولذلك كانت دراستها أمراً ضرورياً للمهتمين بتتبع مسيرة المقدمة التقليدية للقصيدة العربية وتطورها . ومع ذلك لم يلتفت الدارسون إليها ، بل رأيتهم يتنكبون جادتها ، ويزورّون عنها .
وقدخصصت هذا البحث لدراسة مقدمة القصيدة الجاهلية عند حسان، على أمل أن أفرد مقدمة القصيدة الإسلامية عنده ببحث آخر ، ليقيني أن مقدمات قصائده الإسلامية ، يجب أن تدرس مستقلة عن مقدمات قصائده الجاهلية ؛ نظراً للاختلاف بين هذه وتلك في الغاية ، والتصور ؛ والمنطلق ؛ ولأنها تشكل خطوة متقدمة على طريق تطوّر مقدمة القصيدة العربية .
واعتمدت في بحثي هذا على طبعتين من طبعات ديوان حسان : الطبعة التي حققها الدكتور سيد حنفي حسنين ، وصدرت عن دار المعارف بمصر سنة 1974م ، والطبعة التي حققها الدكتور وليد عرفات وصـدرت عن دار صـادر ببيروت سنة 1974م أيضاً ؛ لأنهما أتم الطبعات ، وأحسنها ضبطاً ، ولأن كلاً منهما تتمم الأخرى .
واستبعد البحث مقدمة قصيدته الهمزية ، لأنها وإن نص القدماء على أنها جاهلية ، إلا أن منهم من شكك في بعض أبياتها (1) :
ويدور البحث حول ثلاثة محاور :
- الأول : قصائد حسان التي خلت من المقدمات .
- والثاني : صور مقدمات قصائده الجاهلية .
- والثالث : مظاهر التطوّر في مقدماته الجاهلية .
المحور الأول : قصائد حسان الجاهلية التي خلت من المقدمات
يضم ديوان حسان مائة وخمساً وعشرين قصيدة ، إذا أخذنا بالرأي القائل إن القصيدة تتألف من سبعة أبيات على الأقل (2) . ومن هذه القصائد خمس وثلاثون شكك فيها الباحثون ، وتسعون صححوا نسبتها إليه . والقصائد صحيحة النسبة إليه منها خمس وسبعون إسلامية ، وخمس عشرة جاهلية . ومن قصائده الجاهلية إحدى عشرة قصيدة ذات مقدمة ، وأربع هجم فيها على موضوعه مباشرة ، ولم يمهد لها بأية مقدمة . وتشكل قصائده الخالية من المقدمات 26.66% من قصائده الجاهلية .
وقد عرف الشعر العربي القديم ظاهرةالشروع في القصيدة دون تمهيد، إلى درجة جذبت انتباه ابن رشيق ( ت 456هـ ) ، فسجلها قائلاً : (( ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده مكافحة ، ويتناوله مصافحة )) (3)
والمتأمل في تلك القصائد يجد أن حساناً قالها في مواقف تعرض فيها لاستثارات شعورية ، وجد نفسه فيها مضطراً للرّد الفوري لينفس عـن مشاعره المتوترة ، أو عن انفعالات نفسه الثائرة ، التي لم تتح له فرصة التمهيد لتجربته بمقدمة طللية ، أو غزلية ، أو سوى ذلك ؛ فأقبل على قصيدته دون مقدمة ، وباشر موضوعه دون تمهيد .
فاثنتان من قصائده التي خلت من المقدمات جاءتا رداً على استثارتين مبيّتتين ، فوجئ بهما حسان : أما الأولى فكانت ردّاً علـى تعيير زوجـــه ( عمرة ) (4) له بأخواله ، والفخر عليه بالأوس . وكان حسان يحب أخواله ، ويغضب لهم ، فطلقها ، وقال القصيدة يفتخر ، ومطلعها (5) :
أَجْمَعَتْ عَمْرَةُ صَرْماً فَابْتَكِرْ
إِنما يُدْهِنُ لِلْقَلْبِ الحَصِـــرْ
لاَ يَكُنْ حُبُّكِ هَذا ظَاهِـــــــراً
ليسَ هَذا مِنْكِ يا عمرُ بسرْ
سَألتْ حسانَ من أخوالــــه ؟
إنّما يُسْألُ بالشَّيْءِ الغُمُــر
ومن الواضح أنه قالها في سورة غضبه الذي أدى به إلى طلاق زوجه على الرغم من أن كلاً منهما كان محباً لصاحبه ، كما يقول الخبر (6) .
والمطْلع نفسه يحمل أكثر من إشارة إلى ذلـك ، فهو يأمـر نفسه بعدم الاستجابة لنداء قلبه ، لأنه لا يخضع لنداء العاطفة إلا الضعيف (الحَصِر) ؛ ويعلن ثورة عارمة على تلك الزوجة التي تجاهلت أخواله فسألته عنهم وهي تعرفهم ؛ لأنه إنما يُسأل عن الشيء المجهول . وهو ليس ممن يغضون على الإساءة ، وإن جاءته من أحب الناس إليه . وفي مثل هذه الأجواء الانفعالية ، والجيشان الشعوري ، لا يتوقع المرء أن يمهد الشاعر لتجربته بأية مقدمة .
وأما الثانية فقالها عندما مرّ بنسوة فيهن مطلقته (عمرة ) ، فأعرضت عنه ، وقالت لامرأة منهن : إذا حاذاك هذا الرجل فاسأليه من هو ؟ وانسبيه إلى أخواله . فلما حاذاهنّ سألته ، فانتسب لها ، فقالت له : فمن أخوالك ؟ فأخبرها ، فبصقت عن شمالها وأعرضت، فحدد النظر إليها، وعجب من فعالها ، وجعل ينظر إليها ، فبصر بمطلقته عمرة ، وهي تضحك ، فعرفها ، وعلم أن الأمر من قبلها أتى (7) ، فقال القصيدة ، ومطلعها (8) :
قَالَتْ لَهُ يَوْمَاً تخَاطِبُهُ
نُفُجُ الحَقِيبَةِ غَادَةُ الصُّلْبِ
والموقف الذي تمخضت عنـه القصيـدة يكاد يكون تكراراً للموقف الذي تمخضت عنه قصيدته الأولى والاختلاف بينهما يقتصر على بعض التفصيلات ، والشخصيات ، ولكن جوهر التجربة وباعثها في نفس حسان واحد .
والقصيدة الثالثة التي خلت من المقدمة في شعر حسان الجاهلي قالها في الرد على قصيدة لقيس بن الخطيم(ت620هـ) يوم السرار(9)، ومطلعها(10) :
لَعَمْر أبيكِ الخَيْرِ يا شَعْثَ مَا نَبَا عَلَيَّ لِسَاني في الخُطُوبِ وَلاَ يَدِي
وفيها يمزج الفخر بالتهديد ، فهو يبدأُها بالفخر بمجمل القيم الجاهلية من شجاعة ، وكرم ومقدرة شعرية ، وقدرة على قطع الصحاري الموحشة على ناقة قوية ظهرت في جلدها آثار الأنساع ، يواصل عليها السير ليلاً ونهاراً حتى تبلغه أبواب ملك الحيرة ، ويختمها بتهديد قيس بن الخطيم ، وقومه الأوس ، بأنهم سيلقون من الخزرج ليوثاً تدافع عن عرين وتحمي أشبالاً، ويعيرهم بالهزيمة، والقعود عن الأخذ بالثأر ، وعن بلوغ العلياء ، ثم يتهم قيس بن الخطيم بأنه لا شأن له بالحرب ، لأنه إنما يجيد مغازلة النساء، ومعابثتهن ، والتكحل مثلهن .
ومن الواضح أن حساناً وجد نفسه مضطراً إلى الرد السريع على خصمه ابن الخطيم ، الذي هجا الخزرج وافتخر عليهم بعد قتال بالسرارة استمر أربعة أيام ، نال فيها كل فريق من خصمه ، وأثخـن فيه (11) . وأمام تلـك الظروف الحرجة لم يجد حسان من الوقت ما يتيح له التريث بين يدي القصيدة ، أو التمهيد لها بمقدمة ما ، لإلحاح الرد على نفسه ، وإحساسه بضرورة مقابلة فخر قيس وهجائه بفخر وهجاء مثلهما أو أشد .
والقصيدة الرابعة من هذه القصائد قالها حسان في هجاء شاعر أوسيّ آخر هو أبو قيس بن الأسلــت (12) ( ت قبل الهجرة بقليل ) ، بعد لقاء بين الأوس والخزرج بالبويلة (13) ، اقتتل فيه الفريقان قتالاً شديداً ، ودارت فيه الدائرة على الأوس ، فقالها حسان يهجو أبا قيس والأوس ويفتخر عليهم ، ومطلعها (14) :
أَلاَ أَبْلِغْ أَبَا قَيْسٍ رَسُولاً
إِذَا أَلَقى لَها سَمْعاً يَبِينُ
وبعد أن يلتمس من يبلغ عنه رسالة إلى أبي قيس يذكره بهزيمة الأوس يوم الجسر ، حيث قتل الخزرج والده . وما يلبث أن يهدده بغارة تحيط بالأوس من كل ناحية ، يخضع لها عزيزهم ، وتسقط لهولها الأجنة من بطون الحوامل ، وتشيب الناهد العذراء ، ويتشتت فيها شمل الأوس . ثم يوجـه خطابه إلى أبي قيس قائلاً : تلك غارة يجود فيها غيرك بنفسه ، وتضن فيها بنفسك الخبيثة خشية الموت ، فتسمع الصرخات والاستغاثات ، وتدعى للقتال ، ولكنك تتظاهر بالصمم ، وليس بك صمم . ثم يعيره بمن قتل من الأو .
ومما لا ريب فيه أن حساناً وقد ضجّت في نفسه أحاسيس النصر ، وثب إلى موضوعه دون مقدمة من شأنها أن تؤدي إلى خبّو انفعاله ، أو أن تذهب بحرارة التجربة في نفسه .
لقد عرف الشعر العربي منذ أقدم عصوره إقدام بعض الشعراء على الاستغناء عن المقدمات ، وإقبالهم على موضوعات شعرهم دون تمهيد ، وبخاصة عندما تجيش نفوسهم بانفعالات قوية ، في مواقف طارئة لا تحتمل التريث . ويبدو أنّ ذلك كان شائعاً ومألوفاً ، لأن النقاد أطلقوا عليه عدداً من الأسماء ، ومنها : (( الوثب ، والبتر ، والقطع ، والكسع ، والاقتضاب )) (15) . ووصفوا القصيدة إذا جاءَت على تلك الحال بأنها بتراء ، وشبهوها بالخطبة البتراء . قال ابن رشيق : (( والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء )) (16) .
وما كثرة هذه الأسماء والأوصاف إلا دليل على شيوع ظاهرة إهمال المقدمات ، وكثرة القصائد التي سلك إليها قائلوها هذا المنهج .
وكما نص النقاد على هذا النمط من القصائد ، وسموه بأسمائه ، ووصفوه بأوصافه ، نصوا كذلك على أنّ العرف لم يجْرِ بأنْ يقدم للمراثي بمقدمات تقليدية ، قال ابن رشيق (( ليس من عادة الشعراء أن يقدّموا قبـل الرثاء نسيبا كما يصنعون في المدح والهجاء )) (17) . ونقل عن ابن الكلبي (18) (ت 206هـ ) قوله : (( لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة(19) (ت 8هـ،630م) :
أَرَثَّ جَدِيدُ الحَبْلِ من أُمِّ مَعْبَدِ
بِعَاقِبةٍ وَأَخْلَفَتْ كُلَّ مَوْعِدِ ))(20)
ويعلل ابن رشيق ذلك تعليلاً نفسياً منطقياً ، فيقول : (( لأنّ الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولاً عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة ، وإنما تغزل دريـد بعد قتل أخيه بسنة ، وحين أخذ ثأره ، وأدرك طلبته )) (21) . وطبيعي جداً أن يتخلى شاعر الرثاء عن المقدمات بكل ألوانها وأشكالها ، لأن المقام في الرثاء (( ليس مقام متعة ولهو )) (22) .
وأرى أن تعليل ابن رشيق السابق للمسألة تعليل قائم على فهم صحيح لطبيعة التجربة الشعرية ، وعلى اعتداد بعنصر الصدق الشعوري في العمل الأدبي . وهو ـ في نظري ـ صالح لتعليل خلو قصائد حسان السابقة ، وسواها من المقدمات ، وذلك لأن نفس حسان وإن لم تكن حزينة في قصائده السابقة إلا إنها كانت متوترة ، ومشغولة بما هي آخذة فيه من الفخر والهجاء الذي فجره الموقف في نفسه .
ومع ذلك فإننا نجد باحثا ذا باع طويل في دراسة مقدمة القصيدة العربية، هو الدكتور حسين عطوان يرفض هذه الفكرة ، ويكاد يصر على أنها ترجع في بعض جوانبها إلى ضياع المقدمات من تلك القصائد ، ويكاد يطمئن إلى ذلك في تعليل هذه الظاهرة (23) ، بانياً موقفه ذاك على أساسين :
أولهما: وقوفه على شاهد واحد على ما يذهب إليه ، هو قصيدة النابغة الذبيانـي(ت18ق.هـ/604م) التي رواها الأصمعي على أنها تبدأ بقوله(24):
لقد نَهَيتُ بني ذُبيانَ عَن أُقُرٍ
وعن تَربُّعِهِم في كلِّ أَصْفَار
دون أن يثبت لها مقدمة ، في حين رواها أبو الخطاب القرشي ( عاش قبل منتصف القرن الخامس الهجري ) (25) كاملة ، مع مقدمة ضافية (26) .
ويضيف الدكتور عطوان قائلاً : (( ومن الطريف أن مقدمتها التي وصف فيها الأطلال ، وصاحبته ، ورحلته في الصحراء ، وناقته ، ومنظراً من مناظر الصيد ، تبلغ ما يقرب من خمسين بيتاً )) (27) .
ويستظهر من ذلك ((أنَّ كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها )) (28) ، معقباً بأنه (( ليس في ذلك شك )) (29) .
وثانيهما : (( أنَّ كثيراً من نصوص الشعر الجاهلي ضاع في أثناء رحلته من الجاهلية إلى عصر التدوين )) (30) .
ولا شكَّ أن وجود شاهد واحد حتى ولو كان صحيحاً لا يمكن أن ينهض دليلاً على صحة ما ذهب إليه الدكتور عطوان من أن (( كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها )) ، كما أنه ليس مسوغاً للجزم بذلك إلى حد القول (( وليس في ذلك شك )) ، لأن تعميم حالة قصيدة النابغة تلك على جميع القصائد التي خلت من المقدمات قياس خاطئ قيس الكل فيه على حالة واحدة ، فضلاً عن أنه يتجاهل ما أقرّه نقاد ثقات كابن رشيق من أن (( من الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده مكافحة ، ويتناوله مصافحة وذلك عندهم هو الوثب ، والبتر ، والقطع والكسع ، والاقتضاب وكل ذلك يقال )) (31) .
ثم إن تلك المقدمة المزعومة (( يمكن أن تكون دليلاً على العكس تماماً ، لأنه من المقبول أن يقال إنّ هذه قصيدة وتلك أخرى ، والطول مرشح لذلك ، أو إن هذا الجزء أضيف إلى ذاك .. وخلاف الروايات نفسه ربما يصح دليلاً للشك في أنها قصيدة واحدة )) (32) . كما يقول الدكتور محمد أبو الأنوار .
أما ضياع كثير من نصوص الشعر الجاهلي (( في أثناء رحلته من الجاهلية إلى عصر التدوين )) (33) التي اتكأ عليها الدكتور عطوان في ما توصل إليه من أن (( كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها وليس في ذلك شك )) (34) ، فهي حقيقة تاريخية لا يختلف عليها اثنان ، وقد سبق أن نبه عليها محمد بن سلام ( ت 231هـ ) حين بيّن أنّ العرب لما راجعوا رواية الشعر (( لم يؤولوا إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك، بالموت والقتل ، فحفظوا أقلّ ذلك ، وذهب عليهم فيه كثير )) (35) . كما أثارهـا أبو عمرو بن العلاء ( ت154هـ /770م ) حين قال : (( ما انتهى إليكــم مما قالت العـرب إلا أقلُّه ، ولو جاءَكم وافراً لجاءَكم علم وشعر كثير )) (36) .
ولكن السؤال الذي يبحث عن إجابة هنا هو : هل الإقرار بضياع ما ضاع من نصوص الشعر الجاهلي يمكن أن يتخذ ذريعة للقول بأن كثيراً من القصائد التي خلت من المقدمات قد سقطت مقدماتها ، أو أنها جزء من ذلـك التراث الشعري الذي ضاع ، هكذا على الإطلاق دون دليل مادي ملموس ؟!
ثم كيف لنا أن نمضي مع الدكتور عطوان في اتهام رواية الأصمعي وتوثيق رواية أبي زيد ابن أبي الخطاب القرشي ؟
مع أن القرشي هذا مثار لخلاف عريض حول حقيقة اسمه ؛ وحول حياته ووفاته وحول نسبة مجموعة ( جمهرة أشعار العرب ) إليه .
فمن قائل إنه عاش في أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع (37) ، ومن قائل إنه عـاش قبل منتصف القرن الخامس الهجري (38) ، إلى قائل إنه توفى سنة (170هـ ) (39) .
أما اسمه ففيه من الاضطراب الكثير : فهو تارة أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، وتارة محمد بن أبي الخطاب من غير كنية ، ومن غير نسبة بعد الاسم وتارة ابن أبي الخطاب،وتارة محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري(40) .
وأما حقيقته فلا يقل الخلاف حولها عن الخلاف حول وفاته واسمه ، فهل هو جامع جمهرة أشعار العرب ، أو شارحها ، أو راويتها ؟ (41) مسألة تتضارب حولها الأقوال .
وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة الكتاب وعنوانه ، فالكتاب ينسب حيناً إلى أبي زيد القرشي ، أو محمد بن أبي الخطاب ، وينسب حيناً آخر إلى محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري ، وينسب حيناً ثالثاً إلى أبي عبدالله المفضل بن عبدالله ابن محمد المجبَّر بن عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب (42) .
والمشهور أن عنوان الكتاب هو ( جمهرة أشعار العرب ) ، وقد وردت هذه التسمية عند ابن رشيق في العمدة وعند البغدادي في الخزانة (43) ، ولكن الدكتور ناصر الدين الأسد يذكر أنه اطلع في معهد المخطوطات العربيـة على صورة أصلها مكتبة ( كوبريلي ) عنوانها ( جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام وما وافق القرآن على ألسنتهم واشتقّت به لغتهم وألفاظهم ) ، ويقول إن تلك الصورة((تتفق مع النسخة المطبوعة في العنوان والمحتويات))(44).
هذا فضلاً عن أن جميع من نسبت إليهم هذه المجموعة مجهولون ، فأبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (( مجهول ليس لـه أدنـى ذكر في جميع كتب الطبقات والرجال ، فلم يذكر مع المحدثين ورواة الحديث ، ولا مع اللغويين ، والنحويين ، ولا مع الشعراء والأدباء ، ولا مع مؤلفي الكتب ، وجامعي الدواوين )) (45) .
كما أن المفضل بن عبدالله المجبّري (( مجهول لم تذكره الرجال والطبقات )) (46) .
والأمر كذلك بالنسبة إلى محمد بن أيوب العزيزي العمري ، فهو أيضاً مجهول لم يعثر له على ترجمة (47). وهل هو ((غير محمد بن أبي الخطاب القرشي، أو أنه هو هو ؟ ويكون أبوه أيوب هو أبا الخطاب كنيةً ؟ )) (48) . لم يصل البحث في ذلك كله إلى نتيجة حاسمة .
وخلاصة القول أن نسبة الجمهرة إلى صاحبها (( عقدة تحتاج إلى حل ، والتعريف بصاحبها وترجمته ، عقدة أخرى لا تقل عن الأولى ، وأكثر الرواة الذين يروى عنهم مجاهيل لم نجد لهم ذكراً فيما بين أيدينا من كتب الرجال والطبقات )) (49) كما يقول الدكتور ناصر الدين الأسد ، (( وهي عقدة ثالثة تنافس في الصعوبة سابقتيها )) (50) .
أفبعد هذا الاضطراب الشديد ، والتناقض في الأخبار والروايات ، حول ( جمهرة أشعار العرب ) وجامعها ، يســوغ في عقل أو منطق أن تقدم روايتها على رواية الأصمعي ، بل أن يؤسس على ذلك التقديم بناء حكم عام على ظاهرة أدبية من أهم الظواهر في شعرنا القديم ، وينضوي تحتها كم وفير من القصائد ؟ ، اللهم لا !
ولماذا يقدَّم جامع هذه المجموعة المجهول ، المختلف في اسمه ، ووجوده ، ووفاته على أديب راوية مشهور (51) ، متفوق على أقرانه في رواية الشعر والمعاني (52) . معروف بتشدده وتحريه الدقة في روايته وأنه (( لا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء ، ويقف فيما يتفردون به عنه )) (53) . (( صناجة الرواة والنقلة ، وإليه محط الأعباء والثقلة ، كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأخذ قراءَة نافع عنه ، ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته ، لأنه لم يقو عنده إذ لم يسمعه )) (54) .
ويلاحظ على قصائد حسان التي خلت من المقدمات أنه يغلب عليها موضوع الفخر ، فللفخر منها ثلاث قصائد ، وللهجاء قصيدة واحدة . كما يغلب عليها التوسط في الطول . وطول اثنتين منها اثنان وعشرون بيتاً ، وطول واحدة منها واحد وعشرون بيتاً ، وطول أقصرها سبعة أبيات . ونستطيع القول إن متوسط عدد أبيات قصائده الخالية من المقدمات ثمانية عشر بيتاً في تحقيق وليد عرفات ، وسبعة عشر في تحقيق سيد حنفي حسنين .
وإذا كان حسان قد استغنى عن المقدمات في بعض قصائده ، فقد افتتح تلك القصائد بالصور الآتية :
الأولـى : ذكر المرأة . فهو يذكرهـا في مطلع اثنتين من قصائده ، ويقرن ذكرها بالقسم بصيغة ” لعمري ” في الأولى ، ويذكر عزمها على هجره في الثانية .
الثانية : الحوار . حيث يستهل إحدى تلـك القصائد بحوار يدور بينه وبين المرأة ، يبدأ بلفظ ( وقالت ) .
الثالثة : صيغة التبليغ ” ألا أبلغ”. يفتتح بها قصيدته في هجاء قيس بن الخطيم. وقد جاءَت هذه الاستهلالات مناسبة للتجارب الشعرية التي عبرت عنها القصائد التي استهلت بها .
وهذه الصور من الاستهلال لا تعدو أن تكون أبياتاً مفردة ، لا تدخل في عداد المقدمات (55) .
المحور الثاني : صور المقدمات في قصائده الجاهلية
بلغت قصائد حسان الجاهلية ذوات المقدمات إحدى عشرة قصيدة ، تشكل 73.33% من مجموع قصائده الجاهلية :
والمتأمل في هذه القصائد يلحظ ما يأتي :
- أولاً ـ من حيث الأغراض : يطغى عليها الفخر. فله منها سبع (56) قصائد تشكل 63.63% من مجموعها. وللفخر المتصل بغرض آخر قصيدتان : إحداهما للفخر المتصل بالغزل (57)، والأخرى للفخر المتصل بالمدح(58).وللمدح الخالص منها قصيدة واحدة (59) . وللغزل ووصف الرحيل قصيدة واحدة أيضاً (60) .
وهذا يدل على أنّ المقدمة غير مرتبطة من حيث وجودها وعدمه بغرض القصيدة ؛ وإنما هي مرتبطة بالموقف الذي يوحي للشاعر بالقصيدة ، وبقوة التجربة الشعرية ، وحيويتها في نفس الشاعر .
- ثانياً ـ من حيث الطول : قصائد حسان الجاهلية ذوات المقدمات طويلة نسبيا بالقياس إلى قصائده الجاهلية التي خلت منها . وهي تتراوح بين عشرة وأربعة وأربعين بيتاً.ومتوسط عدد أبيات تلك القصائد أربعة وعشرون (61) بيتاً تقريباً ، في تحقيق سيد حنفي حسنين ، وخمسة وعشرون في تحقيق وليد عرفات(62) . وقد يحمل هذا مؤشراً آخر هو أنّ القصيدة عند حسان كلما طالت كانت أكثر استدعاء للمقدمة .
- ثالثاً ـ من حيث المناسبة : ليس في قصائد حسان الجاهلية ذوات المقدمات سوى قصيدة واحدة اتخذت شكل النقيضة ، قالها يوم خَطْمة (63) ، في الرد على قصيدة للشاعر الأوسي أبي قيس بن الأسلت (64) التي مطلعها (65) :
قَالتْ ولمْ تَقْصُدْ لِقِيل الخَنَا
مَهْلاً فَقَدْ أَبلغْتَ أسْماعِـــــــــــي
ومطلع قصيدة حسان النقيضة (66) :
بَانَتْ لمَيسُ بحبْلٍ منْكَ أَقْطَاعِ
واحْتلَّت الغَمْر تَرْعَى دَارَ أشْراعِ
وقصيدة ابن الأسلت ليست ذات مقدمة . ولكن قصيدة حسان لها مقدمة تقع في ثلاثة أبيات ، يتبعها بيت التخلص .
ولئن كان في هذا بيان فإنه يبدو أن حالة حسان النفسية عند إنشاء القصيدة هي التي كانت تحدد منهجه في بناء القصيدة .
وجميع قصائده ذوات المقدمات لم ينظمها حسان ـ فيما يبدو ـ على عجل ، ولم تكن تجربته فيها وليدة موقف طارئ ، أو انفعال مفاجئ ، وإنما قالها بنفس هادئة ، بعد أن ترك للتجربة أن تنضج في نفسه ببطء ، بعيداً عن التوتر الذي ينتج عن إلحاح المناسبة ، وعن ثورة الانفعال في النفس . ولعل مما يؤكد ذلك أن جميـع هذه القصائد لم يذكر في ديباجتها سوى عبارة (( وقال )) (67) أو (( وقال حسان )) (68) أو (( وقال حسان يفتخر )) (69) أو (( وقال يمدح جبلة ابن الأيهم )) (70) ، وهي عبارات لا تدل في العادة على ارتباط القصيدة بموقف مفاجئ أو طارئ، عدا القصيدة التي رد فيها على أبي قيس بن الأسلت ، فقد جاء في ديباجتها خبر يوم خَطْمة ، ووردت فيها عبارة (( فأجابه حسان بن ثابت )) (71) .
ويبدو أن رد حسان لم يأت سريعاً ، لأنه لا يتضمن أية إشارة إلى ما جاء في قصيدة أبي قيس ، أو إلى يوم خطمة ، وإنما هي فخر عادي لا يختلف عن فخر حسان في معظم قصائده الأخرى ؛ على حين جاءَت قصائـده الجاهلية الخالية من المقدمات وليدة موقف مفاجئ في الغالب ، لم يستطع فيه أن يغالب انفعاله ، فأطلق لسانه بما اعتمل في نفسه دون أية مقدمة ، على النحو الذي سبق بيانه .
ينتمي حسان إلى الجيل الثالث من شعراء العصر الجاهلي ، الذي يمثلون المرحلة الأخيرة من مراحل تطور الشعر الجاهلي وهي المرحلة التي تمخضت عن جهود شعراء جيلين سابقين هما :
شعراء المرحلة الفنية الأولى الذين بنوا على أسس ورثوها عن أسلافهم وتبلورت لديهم المقومات الأساسية لمقدمة القصيدة العربية .
وشعراء المرحلة الفنية الثانية الذين تطوّروا بالمقدمة (( تطوراً أعطاها صورتها النهائية )) (72) ، بما أضافوا إليها من عناصر جديدة ، وبما تخلصوا منه من عناصر موروثة .
والمتأمل في مقدمات حسان الجاهلية يجد تعدداً في صور المقدمات وأشكالها ، كما يلمس تمازجاً وتداخلاً بين تلك الصور والأشكال .
واستقراء مقدمات قصائد حسان الجاهلية يكشف عن ثمانـي صور هي :
- المقدمة الطللية المنفردة .
- المقدمة الغزلية المنفردة .
- المقدمة الطللية الغزلية .
- المقدمة الظعنية الغزلية .
- المقدمة الطللية الظعنية الغزلية .
- المقدمة الطللية الغزلية الوصفية .
- مقدمة الطيف والرحلة .
- مقدمة وصف الليل والظعن .
الصورة الأولى : المقدمة الطللية المنفردة
تعد المقدمة الطللية أبرز المقدمات وأكثرها شيوعاً في الشعر الجاهلي ، ذلك لأنها (( وجدت هوى شديداً في نفوس الشعراء الجاهليين لارتباطها ببيئتهم المادية ، وطبيعة حياتهم الاجتماعية )) (73) .
وعلى الرغم من أن حساناً لم يكن من سكان البوادي ، وإنما من أهل المدن إلا أنه لم يستطع أن يتخلّص من التقاليد الفنية البدوية أو الخروج عليها بحيث يبتدع نظاماً جديداً لمقدمات قصائده ، أو يخالف كل المخالفة نظامها عند شعراء البوادي (74) . شأنه في ذلك شأن جميع شعراء الحواضر أو شعراء القرى العربية كما يسميهم ابن سلام (75) ، يستوي في ذلك الشعراء الذين أمضوا حياتهم فيها أو رحلوا إليها أو (( وفــدوا على قصور الملوك التي كانت تزخر بألوان الحضارة )) (76) .
فقد حرصوا جميعاً على التمسك بأصول هذه المقدمة وعناصرها . ولكن من المؤكد أنّ الصورة العامة للمقدمة الطللية لم تكن جامدة ، بل كانت تحتلف من شاعر إلى آخر (( في التفاصيل والجزئيات ، أو في طريقة العرض ، أو اختيار الألوان والزوايا ، أو في توزيع الظلال والأضواء ، فمثل هذا الاختلاف طبيعي في كل عمل فني أصيل )) (77) .
وتمثل هذه الصورة عند حسان مقدمتان ، إحداهما : مقدمة قصيدته اللامية التي مطلعها (78) :
أسألْتَ رسمَ الدَّارِ أمْ لمْ تسألِ
بينَ الجَوابي فالبُضَيع فَحَوْملِ
وتقع في ستة أبيات ، وقف فيها الشاعر على الأطلال التي اندثرت آثارها وعفت رسومها بين الجوابي ، فالبضيع ، فحومل ، فمرج الصفّرين ، فجاسم ، فتبنى ، وجميعها من منازل الغساسنة في الشام . فسألها عن أهلها الظاعنين ، وتحسر على إقفارها من أحبته الذين كانوا يحلون بها ، ووصف تعاقب الرياح في عرصاتها ، وانهمار الأمطار في ساحاتها ، وكيف طمست معالمها ، وغيرت ما كان يعرفه منها . ثم أرسل دمعه الهتّان لما أثارته تلك المنازل الدارسة ، والديار الموحشة في نفسه من أشجان بعد أن كانت عامرة بأهلها ذوي العز الشامخ والمجد الباذخ ، ثم دلف إلى المدح :
فالمرجِ مرجِ الصُّفَّريْنِ فَجَاسِمٍ
فديارِ تُبنى دُرَّساً لم تُحْلَـــــــلِ
أَقْوى وعُطِّلَ منهمُ فكأنَّــــــــه
بَعْدَ البِلَى آيُ الكتابِ المُجْمَـــــلِ
دِمَنٌ تَعاقبها الريـــاحُ دَوَارسٌ
والمُدْجِناتُ من السِّماك الأعْزلِ
فالعَيْنُ عانِيةٌ تفيضُ دمُوعُها
لمنازلٍ دَرَسَتْ كأنْ لم تؤْهـــــــلِ
دارٌ لقومٍ قد أراهمْ مـــــــــرَّةً
فوق الأَعِزَّةِ عزُّهُم لمْ يُنْقَـــــلِ
ومن الواضح أنّ حساناً تمسك في هذه المقدمة بعدد من مقومات المقدمة الطللية ، وعناصرها ؛ فقد حدّد مكان الديار تحديداً دقيقاً ، يدل على ارتباطه النفسي بها ، وساءَل رسومها عن أهلها ، وشبه أطلالها المقفرة بآثار الكتابة ، وذكر ما درسها من الرياح والأمطار ؛ وإن لم يذكر ما ذرته عليها الرياح من رمال ، وذرف الدموع الغزيرة على ما آلت إليه حال تلك الديار من وحشة ، وعطف بين الأماكن بالفاء .
ولكنه في الوقـت نفسه تخلّى عن عدد آخر من مقومات المقدمة التقليدية ، فلم يسترجع ذكرياته بهـا ، ولم يصف ما بقي من آثارها كالنؤي ، وبقايا الرماد ، والأثافي ، والأوتاد . ولم يتحدث عما حل بها من حيوانات الصحراء ؛ كما تخلى عن فكرة الرفيقين اللذين كان شعراء المرحلة الأولى من حياة الشعر الجاهلي يحرصون على إظهارهما ، وتوجيه الخطاب إليهما ، ولم يخاطب الصحب أو يستوقفهم ، ولم يكن حريصاً على سرد ذكريات يوم الرحيل .
ويبدو أن مسألة التخلص من العناصر الموروثة للمقدمة قد قطعت عند حسان شوطاً أبعد مما كانت عليه عند زهير ومدرسته ؛ فالناظر في معلقة زهير يجد أنه لم يتخلَّ إلا عن قليل من العناصر ، مثل : البكاء على الطلل ، ومخاطبة الرفيقين ؛ ولكن حساناً تخلى عن عدد أكثر من تلك العناصر ؛ بل ليس من المبالغة القول إن ما تخلى عنه أكثر مما أبقى عليه .
ولا يجد قارئ هذه المقدمة الحرص على التفاصيل والجزئيات والعناية بالألوان اللذين يجدهما في مقدمات زهير ، كما لا يلمـس الروية والأناة ، ولا التدقيق في اختيار الألفاظ اللذين يجدهما في معلقته ؛ ومعنى هذا أن اتجاهاً جديداً أخذ في الظهور عند حسان يبدو فيه حرصه على التركيز والتكثيف ، وتظهر فيه نزعة واضحة إلى التخلص من كثير من قيود المقدمة التقليدية ، وتقاليدها الموروثة .
وإذا كان الجنوح إلى التعبير بالصورة يعد مظهراً من مظاهر تطوّر المقدمة الطللية عند شعراء مدرسة الصنعة (79) ، فإن الاقتصاد في التعبير بالصورة يعدّ من العلامات المميزة للمقدمة الطللية عند حسان ، كما يتضح في مقدمته السابقة .
ولعل من الجديد الذي يجدر تسجيله في هذه المقدمة ذكر أماكن تقع خارج الجزيرة العربية .
والمقدمة الثانية التي تمثل المقدمة الطللية المنفردة مقدمة قصيدته الطائية التي مطلعها (80) :
لِمن الدارُ أقْفَرتْ بِبُواطِ
غَيْرَ سُفْعٍ رَوَاكِدٍ كالغَطَاطِ
وهو يفتتحها بالتساؤل عن أهل دار أقفرت من ساكنيها في موضع يدعى ( بواط ) عاثت فيها يد البلى ، فبدلت ملامحها ، وغيرت معالمها ، ولم تبق منها سوى حجارة الموقد السود ، تجثم كأنها القطا الوقع .
ولا يلبث أن يستيقظ من حيرته ، ويجيب على تساؤله الحزين بأنّ تلك الأطلال الدارسة ليست سوى ديار أحبته الظاعنين . وها هي ذي قد أقفرت من أهلها ، وخبت فيها شعلة الحياة ، بعد أن كانت تعج بالحركة والحيوية ، إنها ديار فاتنته ( أم عمرو ) التي ما تزال ذكرياتها حية في نفسه ، وإنه ليذكرها إذ تسأله عن سبب تماديه في هجرها ، بعد أن كانت حبال وده موصولة بحبالها .
وحين تهيج في نفسه الذكرى يلتمس من يبلغها على نأيها بأنه ما يزال مقيماً على عهدها ، يرعى ودها ، ويحفظ سرها ، ثم دلف إلى الفخر.
وظاهرة التكثيف والتركيز تبدو في مقدمته هذه أكثر وضوحاً منها في سابقتها . فقـد اكتفـى حسان في تحديده لموضع الطلل بذكر مكان واحد هو ( بواط ) ، وقاده هذا إلى الاستغناء عن تقليد آخر من تقاليد المقدمة الطللية وهو العطف بين الأماكن بالفاء . وحينما ذكر ما تبقى من آثار الديار اكتفى أيضاً بذكر أثر واحد هو الأثافي ، وضرب صفحاً عن ذكر ما سواه من الآثار التي تطالع قارئ الشعر الجاهلي ، من : نؤي ، وأوتاد ، ورماد وغير ذلك . وعندما شبه الأثافي بالقطا لم يذكر شيئاً من أحوال المشبه به ، بل اقتصر على ذكرها دون وصف في حين دأب شعراء الجاهلية على وصفها بالوقّع أو الجثّم أو غير ذلك . وحين استرجع ذكرياته بذلك الطلل لم يذكر منها إلا النزر ، وأعرض عن ذكريات يوم الرحيل ، وما أثارته في نفسه من مشاعر .
والشخصان اللذان ظهرا مع الشاعر على مسرح الطلل ليسا الرفيقين التقليديين اللذين عهدناهما في مقدمات القصائد الجاهلية ، فالشاعر لم يطلب إليهما أن يسعداه بالبكاء ، ولا أن يتبصرا ليريا الركب يسير في الطرق الرملية بين الكثبان ، وإنما هما مجرد شخصين عاديين يلتمس منها أن يبلغا عنه رسالة .
وحديثه عن وحشة الديار جاء موجزاً مبتسراً ، كما أن الاقتصاد في التعبير بالصورة يعد علامة بارزة في هذه المقدمة ، مثلما هو في المقدمة السابقة .
ومن حيث نزعته إلى التحرر من تقاليد المقدمة الطللية نجده قد استغنى عن عدد منها ، مثل : استيقاف الصحب ، والبكاء على الطلل ، وذكر ما غيره من عوامل الطبيعة ، وما حل به من عين وآرام أو غير ذلك. يقول بعد المطلع :
تلكَ دارُ الألُوفِ أضحـتْ خَلاءً
بعْدَما قد تَحُلُّها في نَشـاطِ
دارُها إذ تَقُولُ ما لابنِ عمروٍ
لَجَّ من بعدِ قُرْبِهِ في شِطَاطِ
بلِّغَاهَا بأَنَّني خَيْـــــــرُ رَاعٍ
لِلَّذي حُمِّلتْ بِغَيْرِ افْـــتراطِ
الصورة الثانية : المقدمة الغزلية المنفردة
حظيت المرأة باهتمام شديد من الشاعر الجاهلي ، فاحتلّت مكانة مرموقة من نفسه ومن شعره ؛ فاستمد وحيه منها ، واستهل قصائده بذكرها ، وتغنى بحبه في مطالعها (81) .
ويمكن القول إنّ المقدمة الغزلية قد انتشرت في الشعر الجاهلي انتشاراً يوازي انتشار المقدمة الطللية (82) .
وإلى جانب سعة انتشار المقدمات الغزلية في الشعر الجاهلي ، فهي أقرب المقدمات نسباً إلى المقدمة الطللية (83) .
فإذا كانت أطلال الحبيبة محور اهتمام الشاعر في المقدمة الطللية ، فإن الحبيبة نفسها هي محور اهتمامه في المقدمة الغزلية .
ويتناول الشاعر في المقدمة الغزلية غالباً موضوعين رئيسين هما :
وصف الحبيبة وصفـاً مادياً أو معنوياً ، والتغني بجمالها الحسي أو النفسي، وإن كان وصف الجمال الحسي ، والتغني بالجمال الجسدي هو الغالب في هذه المقدمة ؛ لأنه (( يتلاءَم مع صورة الحياة الجاهلية الوثنية ، فقد كان العرب لا يزالون ماديين لم ترتق أذواقهم ، ولم تنبل مشاعرهم . ولذلك يكون هذا الضرب من الغزل ألصق بنفوسهم )) (84) .
وتصوير عواطفه ومشاعره تجاهها ، والحديث عن الصد والهجر ، والحنين والهيام ، والوصل والفراق ، والدموع التي تنهل من عينيه ، وذكرياته السعيدة ، وما يتصل بذلك من مناظر الوداع .
وتظهر هذه الصورة من صور المقدمات في قصيدتين من قصائد حسان الجاهلية ، الأولى قصيدته الدالية التي مطلعها (85) :
ألمْ تَذَرِ العيْنُ تَسْهادَها
وَجَرْيَ الدُّموعِِ وَإِنْفَادَهَا
وتقع مقدمتها في ستة أبيات ، وصف فيها سهده ، ودموعه التي لا تنفك تنهمر لفراق صاحبته ( شعثاء ) التي لا تفارق صورتها خياله ، فلا يكف عن ذكرها ، واسترجاع ذكرياته في ديارها التي كانت تنزل بها بعد أن يجودها مطر الربيع المتواصل . ثم عبر عن افتتانه بجمال شعرها المغْدودن الكثيف الذي يثقلها إذا قامت ، ووجهها الذي يحكي وجه غزال ربيب يرتعي أعشاباً يانعة في أرض هطلت بها أمطار غزيرة ، فيبدو في أبهى صورة ، وأروع منظر ، إذ يمضي سحابة نهاره مصعداً في سفوح التلال ، فإذا خيم الليل ولّى وجهه شطر أشجار العضاه ، ليستكنّ بها خوفاً من الأمطار ، يقول :
تذكَّرَ شعثاءَ بعد الكـــــــرَى
ومُلْقَى عِراصٍ وأَوْتَادَهـا
إذا لَجِبٌ من سَحابِ الربيـــعِ
مرَّ بسَاحَتِها جَادَهــــــــا
وَقَامَتْ تُرَائيكَ مُغْدَوْدِنــــــاً
إِذَا ما تنُوءُ بهِ آدَهَـــــــــا
وَوَجْهَاً كَوَجْهِ الغزالِ الرَّبيبِ
يقْرو تِلاعاً وَأَسْنَادَهـــــا
فَأَوَّبَه الليلُ شَطْر العِضـــــاهِِ
يَخَافُ جِهاماً وصُرَّادهــــا
وتخلو هـذه المقدمة الغزلية من عنصر مهم من عناصر المقدمات الغزلية التقليدية ، وهو وصف منظر الوداع والفراق المألوف . وتقتصر علـى وصف بعض مظاهر جمال صاحبته ، ووصف عواطفه تجاهها . ففي الجانب الأول اكتفى بالحديث عن شعرها الكثيف الطويل ، ووجهها الذي يشبه وجه غزال غذي أطيب غذاء . وفي الجانب الثاني ذكر سهده ودموعه التي لا تكف عن الانحدار، ولكنه مزج ذلك ببعض مظاهر الطبيعة التي جعلها إطاراً أو خلفية للمشهد العاطفي فاختار لسهده ودموعه وقتا نام فيه النـاس ، وسكن فيه الكون ، واختار للشعر المغدودن لوحة تبدو فيها الأرض خصبة ممرعة ؛ واختار لجمال الوجه صورة لا أبهى ولا أسنى هي وجه الغزال الربيب الذي يقصد الأماكن المرتفعة التي لا تطأها الأقدام فيرتعي بها ، حتى إذا خيم الليل أوى إلى كناسه الذي اتخذه في شجر العضاه ؛ ليتعانق جمال الإنسان وجمال الطبيعة في تشكيل اللوحة الغزلية .
والثانية قصيدته العينية التي مطلعها (86) :
بانَتْ لَميسُ بِحبْلٍ منكَ أَقْطَاعِ
واحْتَلَّت الغَمْرَ ترْعَى دَارَ أَشْرَاعِ
ومقدمتها الغزلية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أبيات اقتصر فيها على الحديث عن هجر صاحبته ( لميس ) ، وانقطاع حبال وصالها ، وارتحالها إلى مكان كثير المياه ، ذي مراع خصبة ، ومجاورتها في ديار بني عمرو بن نصر ، وهم قوم ذوو عِزّ ومنعة ، يحمون أرضاً ممرعة ، ثم وصف حالته النفسية عندما تحركت المراكب بصاحبته في الفجر إذ انهمرت دموعه كأنها ماء يفيض من دلاء كبيرة ممتلئة . قال :
وأصْبَحَتْ في بني نَصْر مُجَاورَةً
ترْعَى الأَبَاطِحَ في عـــــزّ وإِمْراعِ
كأنَّ عَيْنَيَّ إذْ وَلَّتْ حُمُولُهُـــــمُ
في الفَجْرِ فَيْضُ غُروبٍ ذاتِ إِتْراعِ
ومن الواضح أنه مسّ موقف الوداع مساً خفيفـاً ، فاكتفى بذكر تحرك موكب الرحلة ، وتحديد زمنه .
والتكثيف والتركيز هما الظاهرة البارزة في هذه المقدمة ، وكأني بحسان وهو يردّ على أبي قيس بن الأسلت ، وينقض عليه قصيدته التي سبقت الإشارة إليها ، كان يتطلع إلى الوصول إلى موضوعه مسرعا ، فأعجله ذلك عن التفصيل، وألجأه إلى التكثيف والتركيز .
يتبين مما سبق أن حسان في مقدمتيه الغزليتين لم يتبع التقاليد الموروثة في المقدمة الغزلية ، ولم يحذُ حذو الشعراء الجاهليين الذين سبقوه ، فجاءَت مقدمتاه موجزتين ؛ كما يلاحظ فيهما اهتمامه بإدخال عناصر الطبيعة ، وبخاصة الماء ، والخصب .
الصورة الثالثة : المقدمة الطللية الغزلية
وفي هذه الصورة يتضافر على تشكيل المقدمة لوحتان: لوحة الأطلال ، ولوحة الغزل . ففي اللوحة الأولى يصور الشاعر (( أطلال الحبيبة الراحلة التي عفت وأقفرت بعد رحيلها ، وما يراه فيها من آثار الحياة الماضية التي كانت تدب فيها أيام كانت آهلة بأصحابها ، قبل أن تتحول بعدهم إلى مجرد أطلال موحشة ، تسفي عليها الرمال ، فتحجبها ، وتخفي معالمها ، وتهب عليها الرياح فتكشفها ، وتبدي رسومها ، وأسراب الحيوان الوحشي تسرح في ساحاتها آمنة مطمئنة ، حيث لا إنسان يفزعها أو يثيرها )) (87) .
وطبعي أن يستدعي هذا الإطار المكاني وما يثيره في النفس من مشاعر ، العنصر الإنساني ، فيتبع الشاعر لوحة الطلل بلوحة صاحبته التي نأت ، فيقبل عليها واصفاً جمالهـا (( ويلح علـى تبيان محاسنها ، حتى يكاد يظهرها عضواً عضواً ، ولا يترك شيئاً منها ، بل يأتي على كل شيء ، كأنما يريد أن يشخص هذه الأعضاء تشخيصاً )) (88) ، ولا بدّ أن يثير استدعاؤه لصورة صاحبته ، واستحضاره لجمالها ، في نفسه الحسرة على أيامه الخالية ، وذكرياته الماضية ، (( فيصور حبه وغرامه ، وآلامه وأحزانه ، ويأسه وحرمانه ، فيذرف الدموع ، ويسفح العبرات )) (89) على ماضيه المنصرم .
وقد تبنى حسان هذه الصورة من صور المقدمات في قصيدتين من قصائده الجاهلية ، أولاهما : قصيدته الميمية التي مطلعها (90) :
لِمْن مَنْزلٌ عَافٍ كأنَّ رُسُومَهُ
خَيَاعيلُ رَيْطٍِ سَابرِيٍّ مُرَسَّمِ
ومقدمتها ثانية مقدمات حسان من حيث الطول ، وتبلغ ستة عشر بيتاً . وهو يستهلها بالسؤال عن أهل منزل عفت رسومه ، وأقوت معالمه ، ودرست آثاره حتى غدا كثياب فارسية رقيقة مخططة لا أكمام لها . إنه منزل مقفر خال من آثار الحياة ودلائلها ، إلا من ثلاث أثافٍ ركّد ، كأنها ثلاث حمائم جُثَّم ، ومن وتد بال ، وبقايا حائلة كأنها ثوب قديم موشى .
لقد عاثت رياح الصيف في ذلك المنزل ، فهي تعتاده مرّة إثر أخرى ، فيتجمع هشيمه الجاف على بقايا نؤي قد تثلمت حوافه ، وامتدت إليه يد البلى فكسته من سرابيلها الدائرة ، كما عبثت في معالمه سحب سود ضخمة كأنها الجبال ، يثقلها ما تقل من أمطار ، تزجيها الرياح وتقصف في جوانبها الرعود ، ويومض البرق ، وما تلبث عراها أن تنفصم عن مطر غزير مسح متواصل .
إنه يعهد ذلك المنزل عامراً بأهله الذين تجمع بينهم البهجة ، وترفرف عليهم الغبطة ، وتخيم عليهم الأُلفة ، وتربطهم أواصر المحبة ؛ فهل إلى حبال الـود التي رثّت مـن عـودة ؟ ويستيقظ الشاعر من تلك الأحلام اللذيذة ، والذكريات الوادعة ، على قسوة واقعه المر ، فقد نأت دار ليلى ، وتبدلت بوصلها هجراً ، وبودّها صداً ، وبقربها نأيا ، وانبتت حبال الوصل التي كانت ممتدة بينهما ، بعد أن أصغت ليلى إلى حديث الواشين والكاشحين .
وإذا كانت الأيام وتقلباتها قد غيرت من مشاعر ليلى نحوه ، فإنه ما يزال مقيماً على الود يتشبث بحباله ، ويرعى ذكرياتـه ، ويصـون أسراره ، ويحرص كل الحرص على كتمانه بين ضلوعه . وسيبقى حفيا بودها ، على الرغم من صدها وهجرها ، وإصغائها إلى الذين روّجوا عنه الأقاويل والأراجيف. يقول حسان :
خَلاءُ المَبَادِي ما بهِ غيرُ رُكَّــــــدٍ
ثَلاثٍ كأَمْثالِ الحَمَائِمِ جُثَّــــمِ
وغيرُ شَجِيجٍ ماثِلٍ حالَفَ البِلــــى
وَغَيْرُ بَقايا كالسَّحيقِ الْمُنَمْنَــــمِ
تَعِلُُّ رباحَ الصيفِ بالي هَشيمِــــهِ
على ماثِلٍ كالحَوْضِ عافٍ مُثَلَّــــمِ
كَسَتْهُ سَرابيلَ البِلَى بَعْدَ عَهْـــدِهِ
وَجَوْنٌ سَرَى بالوابِـــلِ الْمُتَهَزِّمِ
وكُلُّ حثيثِ الوَدْقِ مُنْبَجِسِ العُرَى
مَتَى تُزْجِهِ الرِّيحُ اللواقِحُ يَسْجُـمِ
ضَعيفُ العُرى دانٍ من الأرضِ بَرْكُـهُ
مُسِفٍّ كمثْلِ الطَّوْدِ أكظَمِ أَسْحَـمِ
وَقَدْ كانَ ذَا أَهْلٍ جميعٍ بغبطـــة
إذَ الوصلُ وصلُ الودِّ لمْ يَتَصَـرَّمِ
وإذْ نحنُ جيرانٌ كثيرٌ بِغِبْطَـــــــةٍ
وإِذْ ما مَضَى من عَيْشِنَا لم يُصَـــرَّمِ
فإِنْ تَكُ ليْلَى قَدْ نَأَتْكَ ديارُهـــــا
وَضَنَّتْ بِحَاجَاتِ الفُؤادِ المُتَيَّـــمِ
وهَمَّتْ بِصَرْمِِ الحَبْلِ منْ بعدِ وَصْلِـهِ
وَأَصْغَتْ لقوْلِ الكَاشِحِ المُتَزعِّــمِ
يُغَيِّرُهُ نَأْيٌ ولوْ لمْ تَكَلَّــمِ
وإنْ صَرَّمَ الخُلاَّنُ بالمُتَجَــــذِّمِ
لَديَّ فَتَجْزِيني بِعاداً وتَصْرمـــي
وما كَظَّ صَدْري بالحديثِ المُكَتَّــمِ
عَليَّ ونَثُّوا غَيْرَ ظَنٍّ مُرَجَّـــمِ
وحسان في لوحة الطلل في مقدمته السابقة يبدو أكثر ميلاً إلى الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات ، وأقل تشبثاً بالتركيز والتكثيف . ومع ذلك فهي لم تستوف جميع عناصر المقدمة الطللية التي تمسك بها شعراء المرحلتين الأولى والثانية من العصر الجاهلي .فقد سكت فيها حسان عن كثير من التقاليد الأساسية في المقدمة الطللية ، فهو لم يستوقف الصحب ، ولم يطلب إلى رفيقيه أن يسعداه بالبكاء ، كما لم يسفح الدموع على الطلل المحيل ، ولم يحدد مكانه بذكر أسماء المواضع ، ولم يعطف بعضها على بعض بالفاء ، ولم يتعرض لقطعان الظباء وبقر الوحش والنعام في معرض حديثه عن إقفار الديار ووحشتها ، وغض الطرف عن ذكر ما حلّ بها من حيوان .
ومن جهة أخرى حافظ حسان على عناصر تعد من مقومات المقدمة الطللية ، فاستفسر عن الأهل الظاعنين ، واسترجع ذكرياته بالديار ، وذكر ما تبقى من آثارها ، وما درسها من الرياح والأمطار . وشبه بقاياها بخطوط الثوب المطرّز ، كما شبه الأثافي بالحمائم الجثم ، وذكر ما ذرته الرياح فوقها من هشيم يابس .
ومن مظاهر ميله إلى الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات في هذه المقدمة استعانته الواضحة بالتصوير البياني القائم على التشبيه في المقام الأول ، ثم على الاستعارة : فقد شبه الرسوم البالية بثوب فارسيّ بلا كمين ، خيط أحد شقيه ، وبثوب خلق موشى ، وشبه الأثافي الباقية بالحمائم الجاثمة ، والنؤي الدارس بالحوض الذي تكسرت حوافه . واستعار العلل والنهل لهبوب الرياح علــى الأطلال مرّة إثر أخرى . وجعل الوتد حليفاً للبلى ، والسحاب حين يدنو من الأرض حيواناً جاثماً ، والرياح تكسو الأطلال سرابيل البلى ، وانهمار المطر عليها عرى تنفصم ، والسحب الموقرة بالمطر جبالاً سوداً .
ويظهر ميله إلى التفصيل أيضاً في ذكره لما تبقى من آثار الديار ، حيث ذكر الأثافي ، والوتد والنؤى ، ورسم لكل منها صورة بيانية .
وفي ذكره لمنزل أحبته لم يكتفِ بوصفه بالعافي ، وبخالي المبادي ، وببالي الهشيم ؛ بل أضاف إلى هذه الأوصاف تشبيهه بالخياعيل السابرية المرسمة ، وبالسحيق المنمنم .
ويبدو هذا الميل أيضاً في وصفه للسحاب وما يتصـل به من رعد ومطر، فقد وصفه بأنه أسود ، يتفجّر قطره ليلاً بغزارة واستمرار ( يسرى بالوابل ) ، وبأنه منبجس العرى ، حثيث الودق ، دان من الأرض ، يقصف رعده ، ويومض برقه . هذا فضلاً عما رسم له من الصور .
ويبدو أن هذه اللوحة هي أكثر لوحات حسان الطللية قرباً من مقدمات زهير وأصحابه من شعراء المرحلة الثانية ؛ حيث بذل فيها حسان جهداً فنياً واضحاً ، واهتم بالتفاصيل والجزئيات ، وعني باختيار الظلال والألوان ، والزوايا ، وعبر من خلال الصور البيانية .
وفيما يتعلق باللوحة الغزلية في هذه المقدمة ، فقد اقتصر فيها حسان على التعبير عن لواعجه ، وعواطفه ، وما اكتوى به من وجد ، ولوعة ، وعلى الحديث عن وفائه ، وتشبثه بحب صاحبته ، وإنْ بدا منها صدّ وصرم ؛ كما عرض لذكريات أيام الوصل ، قبل أن يقلب له الدهر ظهر المجن ، ويتبدل بالغبطة حزناً ، وبالوصل صرماً ، وبالود هجراً .
ولكنه ضرب صفحاً عن وصف مشهد الوداع الشائع في المقدمات الغزلية ، ولم يصف صاحبته وصفاً حسياً أو معنوياً ؛ أو يتغن بجمالها الجسدي أو النفسي كما لم يصرح بذكر اسمها .
وساد عبارته في هذه اللوحة السرد . وقلّ فيها اعتماده على الصورة ، كما هو الأمر في اللوحة السابقة ( لوحة الطلل ) ، فلم يستعن بالصورة إلا في استعارة الحبل لعهد الحب ، حيث جعله حبلاً واهياً منجذماً رثاً من طرفها ، وعلى عكس ذلك من طرفه . كما جنح إلى السهولة والرقة في هذه اللوحة لأنه يعبر عن عواطفه ، ويمتح من نفسه ، فتخفف من غرابة اللفظ ، وجزالة العبارة اللتين وسمتا عبارته في اللوحة الأولى ، وفرضهما عليه فيما يظهر تشبثه بتقليد السابقين ، ومجاراتهم في لوحة الطلل .
والثانيـة : قصيدته النونية التي يمدح بها جَبَلة بن الأيهم صاحب التاج الغساني ، ومطلعها (91) :
لمنِ الدّارُ أوْ حَشَتْ بِمَعــــانِ
بين أَعْلى اليَرْموكِ فالخَمَّانِ
وعدتها عشرة أبيات ذهبت المقدمـة منها بثمانية . وفي ذلك ما يشير إلى أن المدح قد حذف منها ، لأنها تقف عند قوله :
قدْ أَراني هُنَاكَ حَقَّ مَكِينٍ
عِنْدَ ذي التَّاجِ مَقْعَدي وَمَكَاني
وهي كسابقتها تسهم في تشكيل مقدمتها لوحتا الطلل والغزل . أما لوحة الطلل فيستهلها بالوقوف على بقايا دار أقفرت من ساكنيها ، فخيمت عليها الوحشة ، وتسللت إليها عوامل البلى ، فيسأل عن مصير أهلها الذين هجروها، ثم يحدد موقعها تحديداً دقيقاً ، كأنه يريد أن يحفرهـا حفراً في ذهن السامع، مما يدل على شدّة تعلقه بها؛ فيذكر أماكن شامية من أعمال دمشـق ، بعضها ناء عنها ، وبعضهـا قريب منها ، يعد من ضواحيها ، وبعضها يقع جنوبي الأردن، أو بين دمشق وبحيرة طبرية ، وهي : معان ، والخمان ، وبلاس ، وداريا ، وسكاء ، وجاسم ، وأودية الصفّر ، وجميعها من منازل الغساسنة .
ثم يشيد بتلك المواضع ، وبما شهدته منازلها من عزّ ومجد ، فقد كانت تعج بقنابل الخيل والفرسان ، وبكرائم الإبل وبيضها ، ويطلق عليها لقب ( دار العزيز ) ، ويستعيد ذكرياته بها ، أيام زياراته المتكررة لها في عهد الحارث بن أبي شمر الغساني ، فيقول بعد المطلع :
فَالقُرَيَّاتُ مِنْ بَلاَسَ فَدَارِيَّا
(م) فَسَكَّاءَ فَالقُصُورُ الدَّوانِي
فَقَفَا جاسمٍ فَأَوْدِيةِ الصُّفَّر
(م) مغنى قَنَابِلٍ وهِجَــــــــانِ
تِلْكَ دارُ العَزيزِ بَعْدَ أنيـسٍ
وَحُلُولِ عَظِيمةِ الأَرْكَـــانِ
هَبِلَتْ أُمُّهُمْ وَقَدْ هَبِلَتْهُـــمْ
يومَ حَلَّوا بِحَارثِ الجَوْلانِ
وهنا ينقلنا مـن لوحة المكان إلى اللوحـة الغزلية ، لوحـة الإنسان ، فيرسم لوحة تعج بالفتنة والحياة ، ومظاهر الترف والنعمة ، تظهر فيها الجواري الحضريات عاكفات على نظم أكلّة المرجان ، أو مجتنياتِ زهور الزعفران ، أو متطيبات بدهنه ، في مآزرهن البيض الرقيقة ، وثياب الكتان المضمخة بالعطور ، استعداداً ليوم عيد الفصح .
وينهي حسان لوحته الغزلية بالتعبير عن فتنته وإعجابه بالمرأة الحضرية من خلال موازنة طريفة يعقدها بين ولائد الغساسنة المترفات ، والأعرابيات من نساء البادية ، اللاتي يجتنين صمغ المغافير أو الثُّمام ، ليستعملنه في تلبيد شعورهن ، أو ينتقفن الحنظل عنـد نضجه لاستخـراج ما فيه ، واستخدامه في إصلاح أحوالهن . يقول :
قد دنا الفِصْحُ فَالَولائدُ يَـ
(م) ـنْظِمْنَ قُعودَاً أَكِلَّةَ المَرْجَانِ
يَجْتِنينَ الجَادِيَّ في نَقَـــبِ
الرَّيْطِ عَلَيْها مَجَاسِدُ الكتَّانِ
لمْ يُعَلَّلْنَ بِالمغَافِرِ والصَّمْغِ
(م) وَلاَ نَقْفِ حَنْظَلِ الشَّرْيَـــــانِ
ولوحة الطلل من مقدمة حسان السابقة تفتقر إلى كثير من العناصر التقليدية للمقدمة الطللية ، كاستيقاف الصحب ، ومخاطبة الرفيقين ، والبكاء على الطلل ، وذكر ما بقي من آثار الديار من أثاف ، ونؤي ، وأوتاد ، وغير ذلك ، ووصف ما درسها من عوامل الطبيعة ، وما حل بها من قطعان الظباء ، وبقر الوحش . كما تخلو من الصور التي اعتاد الشعراء الجاهليون رسمها لبعض عناصر المقدمة ، مثل تشبيه بقايا الديار بخطوط الثوب المطرز ، وتشبيه ما ذرته الرياح من رمال بالطحين المتناثر ، وتشبيه الأثافي بالحمائم الجثم .
ويبدو أنّ ما أبقى عليه الشاعر من تلك العناصر قليل قلـة واضحة قياسـاً إلى ما تخلـى عنه ، إذ لم يبق إلا على ذكر أسماء المواضع ، وتحديدها تحديداً جغرافياً دقيقاً ، والعطف بينها بالفاء ، والاستفسار عن أهلها الظاعنين ، واسترجاع شيء من ذكرياته بها . وحتى هذه العناصر طرأ عليها بعض التطوّر ، فالمواضع التي ذكرها مواضع شامية ، لم تعرفها المقدمات التقليدية قبل حسان .
فضلاً عن أن ذكريات الشاعر بتلك الأماكن لا تثير في نفسه الوجد والصبابة بقدر ما تثير الإعجاب بأمجاد الغساسنة وعزّهم . وهو لا يتحدث عن الظعن والمراكب التي تقلّ نساء الحي ، وبينهن صاحبته ، ولكن عن جماعات الخيل ، وكرائم الإبل التي يقتنيها الغساسنة .
وإذا كانت اللوحة الطللية من مقدمته السابقة قد أصابت هذا القدر من التطوّر ؛ فإن اللوحة الغزلية من تلك المقدمة قد انحرفت انحرافاً كبيراً عن مناهج الجاهليين وطرائقهم ؛ فهو لم يذكر امرأة بعينها ، وإنما وصف الجواري اللاتي كان يراهن في بلاط الغساسنة ، ولم يتغن بجمال المرأة الحسي أو النفسي ، بل كان مبهوراً بزينتها وعطورها ، من أكلّة المرجان ، وطيوب الزعفران ، ومجاسد الكتان . وعواطفه تجاهها لم تكن هياماً ، ووجداً ، ولهفة ، ولوعة ؛ ولكن كانت إعجاباً بالطيوب ، والثياب ، ومظاهر الزينة . وهو لم يتحدث عن محاسنها حديثاً مكشوفاً كما كان يفعل امرؤ القيس أو الأعشى ، أو المنخل وسواهم ، كما لم يصف مشهد الوداع أو الرحيل . وأهم من ذلك أنه ضمّن لوحته عنصراً جديداً لم تعهده المقدمات الغزلية التقليدية ، يتمثل في تفضيل المرأة الحضرية التي تعيش في قصور الغساسنة ، على البدوية التي تتخذ وسائل الزينة البدائية ، فتلبّد شعرها بصمغ الثُّمام ، وتنتقف الحنظل .
الصورة الرابعة : المقدمة الظعنية الغزلية
هذه صـورة أخرى من صور المقدمات في قصائد حسان الجاهلية ، وهي تتألف من لوحتين : لوحة الظعن ، واللوحة الغزلية .
ومقدمة الظعن من المقدمات الرئيسة في القصيدة الجاهلية ، إذ تتراءَى في سماء الشعر الجاهلي أسراب منها (( تعود إلى فترة مبكرة من عمره ، تدل بقدمها على رسوخها وأصالتها ، آية ذلك أنها تطالعنا في قصائد الشعراء المتقدمين ، مثل : المرقش الأكبر ، وعبيد بن الأبرص ، وسلامة بن جندل ، وطفيل الغنوي ، وبشر بن أبي خازم )) (92) .
ولحسان قصيدة جاهلية في الفخر يستهلها بهذه الصورة من صور مقدماته ، يبدأُها بلوحة الظعن ، وفيها يلتمس من خليله بباب جلِّق أن يتبصر لعله يرى ركباً قادمين من تلقاء البلقاء ، ثم يخبره بأن قافلة صاحبتـه ( شعثاء ) قد انطلقت من مكان يسمى المحبس وانحدرت بين المرتفعات ، تحمل نسوة حور العيون ، نقيات البشرة ، بيضاوات الوجوه ، يلتحفن ملاءات حريرية ، وتبدو عليهن آثار النعمة ، والترف .
ويتابع حسان رحلة هاتيك الظعائن ، فيخبر صاحبه أنهن قد مررْن ببصرى الشام، واجتزن جبل الثلج ( يريد جبل الشيخ ) الذي يعانق السحب ، يقول (93) :
انْظُرْ خَلِيلي بِبابِ جِلَّقَ هــَلْ
تُؤْنِسُ دونَ البَلْقاءِ من أَحَدِ
أَجْمَالَ شَعْثَاءَ قَدْ هَبَطْنَ مــــن المَـ
ـحْبَسِ بَيْن الكُثْبَانِ فَالسَّنَدِ
يَحْمِلْنَ حُوَراًحُوْرَ المَدَامِعِ فــي الرَّ
يْـطِ ، وبيضَ الوُجُوهِ كالبَرَدِ
منْ دونِ بُصْرَى وَدُونَها جَبَلُ الثَّلْجِ
عَلَيهِ السَّحَابُ كالقِـــــــــدَدِ
وفي اللوحة الغزلية من هذه المقدمة يقسم حسان برب الإبل التي ذللها كثرة الارتحال، وما تقطع من صحارى شاسعة، وبرب الإبل التي قرّبت للنحر ، يميناً برة لا يحنث فيها ، أنه أحبّها حباً لم يتطرق إليه وهن ، أو يعتريه فتور ، وأنه لم يحب امرأة حبه إياها :
إِنِّي وَرَبِّ الْمُخَيَّسَاتِ وَمَــــــــا
يَقْطَعْنِ مِن كُلِّ سَرْبخٍ جَـــدَدِ
وَالبُدْنَ إِذْ قُرِّبَتْ لِمَنْحَرِهَــــــــا
حِلْفَةَ بَرِّ اليَمِينِ مُجْتَهِــــــدِ
مَا حُلْتُ عَنْ خَيْرِ مَا عَهِدْتِ وَمَـــا
أَحْبَبْتُ حُبِّي إِيَّاكِ مِنْ أَحِــدِ
وهو في لوحة الظعن لم يأت إلا على ذكر الطريق الذي سلكته الظعائن، حيث وصفه وصفاً دقيقاً يدل على شدّة وجده ، وتعلقه بصاحبته ( شعثاء ) ، وذكر عدداً من المواضع الشامية ، وهي : البلقاء، وجلق ، والمحبس ، وبصرى ، وجبل الثلج . في حين أغفل كثيراً مـن العناصر التي يجدها الدارس في مقدمات الظعن الجاهلية، مثل : وصف الاستعداد للرحيل ، ووصف الإبل وهوادجها ، وما يعلوها من ثياب وألوان ، والحادي والدليل ، والغاية ، ومنتهى الرحلة . وحتى حين وصف الطريق الذي سلكته الظعائن اكتفى بتحديده ، ولم يعرض لما يحف به من مخاطر ، وما يتناثر على جانبيه من رمال ، وعيون مهجورة ، أو صالحة (94) .
ويقابل ذلك استيفاؤه لمعظم عناصر اللوحة الغزلية ، فقد وصف صاحبته ( شعثاء ) وصفاً حسياً ، وتغنى بجمال عينيها الحوراوين ؛ وأعرب عن فتنته بوجها الناصع ، النقي ، ورسم لها ولصواحبها صورة بالغة الدلالة على ذلك النقاء هي صورة البَرَد . وتحدث عن وفائه وإخلاصه لها ، وشدّة وجده وهيامه بها ، وأقسم على ذلك أغلظ الأيمان إلا إنه لم يبالغ في وصف مظاهر جمالها ، ولم يتحسر على أيامه الماضية .
ويبدو حسان في هذه المقدمة مُقْتَصِداً في استخدام الصورة الشعرية ، ميالاً إلى السرد ، إذ لم يأت إلا بصورة البَرد ، ليعبر من خلالها عن نقاء لون صاحبته ، وصورة القِدد وهي القطع ليخلعها على السحب المتناثرة التي تعانق قمة جبل الشيخ .
ولكنه لوّن في صور الأداء ، فاستعان بالأساليب الإنشائية كالنداء ، والاستفهام ، والأمر ليجذب اهتمام السامع ؛ وراوح بين الإنشاء والخبر ، كما أفاد من أسلوبي القسم والتوكيد في تقوية شحنة العاطفة فيها . وبدا ميالاً إلى التفصيل في صورة الإبل التي تساق للنحر ، وفي وصف الطريق الذي سلكته الظعائن .
ولعل من الجديد في هذه المقدمة ذكره للأماكن والمواضع الشامية ، وبخاصة جبل الثلج أو جبل الشيخ .
الصورة الخامسة : المقدمة الطللية الظَّعْنيَّة الغزلية
تلتقي في هذه الصورة من صور المقدمات في قصائد حسان الجاهلية ثلاث لوحات : لوحة الطلل ، ولوحة الظعن ، واللوحة الغزلية .
وبهذه الصورة استهل حسان قصيدته الفخرية الميمية التي مطلعها (95) :
ألَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ الجَديدَ التَّكَلُّمَا
بِمدْفَعِ أَشْدَاخٍِ فَبُرْقَةَ أَظْلَما
وهي من أطول مقدماته . وتقع في ستة عشر بيتاً . وقد افتتحها بلوحة الطلل فوقف عليه ، وسأله عن الربع الدارس الذي استعجم عن رد جوابه ، وكيف يجيبه رسم أبكم ؟ إنه طلل دار تقع في مكان خصيب ، يندفع بين ربوعه وادي أشـداخ بالقـرب من جبل أظلم ، ماراً بمنعطف وادي نقيع ، حيث تستوي الأرض في بطن يَلْبَن .
لقد أقفرت تلك الديـار ، وخلـت مـن أهلها الذين عمروها زمنا ، فقد غادروها إلى تهامة . إنها ديار صاحبته التي طالما تردّدت على جبلي تغلم ، ووادي المراض الذي ترعرع في عدوتيه شجر الأراك وأينع ، وتمايلت أغصانه مزهوة بخضرتها .
وحين انقضى فصل الربيع صوّح المرعى ، ولم تعد تسمع سوى حمحمة الرعد ، تتجاوب أصداؤها مع حنين مطافيل الإبل التي نتجت في فصل الربيع ، فيتردد صداه في أكناف وادي العقيق ، وهضبة الجمَّاء ، حتى إذا ارتفع سحابه فوق تُرْبان ، انفصمت عراه ، وانهلّ ودقه ، وألقى بعاعه ، وتمخض عن سيل هادر يقتلع كل ما يعترضه من شجر العضاه . يقول حسان بعد المطلع :
أَبَى رَسْمُ دارِ الحَيِّ أَنْ يَتَكَلَّمَــا
وهلْ يَنْطِقُ المَعْرُوفَ منْ كانَ أبْكَمَا
بقَاعِ نَقَيعِ الجِزْعِ من بَطْنِ يَلْبَـــــنٍ
تَحَمَّلَ مِنِهُ أَهْلُهُ فَتَتَهَّمَـــــــا
دِيَارٌ لشَعْثَاءِ الفؤادِ وَتِرْبِهــــا
ليَاليَ تَحْتَلُّ المَراضَ فَتَغْلَمَـــــا
وإِذْ هِيَ حَوْرَاءُ المَدَامِعِ تَرْتَعِــــي
بِمُنْدَفَعِ الوادي أَرَاكاً مُنَظَّمَـــا
أَقَامَتْ بهِ في الصَّيْفِ حَتَّى بَدَا لهَا
نَشَاصٌ إِذَا هَبَّتْ لهُ الرِّيحُ أرْزَمَـا
فَلَمَّا دَنَتْ أغضَادُهُ وَدَنَا لَـــهُ
منَ الأرْض دَانٍ جَوْزُهُ فَتَحَمْحَمَا
تَحِنُّ مَطَافِيلُ الرِّباعِ خِلالَـــهُ
إذا اسْتَنَّ في حَافاتِهِ البَرْقُ أَثْجَما
وَكَادَ بأكْنَاف العَقِيقِ وَئيـدُهُ
يَحَطُّ من الجَمَّاءِ رُكْنَاً مُلَمْلَمَـا
فلما علا تُرْبَانَ وانْهَلَّ وَدْقُــهُ
تَدَاعَى وأَلْقَى بَرْكَهُ وتَهزَّمَــــا
وأَصْبَحَ منْهُ كُلُّ مَدْفَعِ تَلْعــــةٍ
يَكُبُّ العَضَاهَ سَيْلُهُ مَا تَصَرَّمَـا
وواضح أنه لم يبك أو يستبك ، ولم يستوقف الصحب ، ولم يخاطب الرفيقين اللذين اعتدنا رؤيتهما في مشهد الطلل ، ولم يصف ما بقي من آثار الديار ، من أثاف ، ونؤي وأوتاد ، أو ما حل بها من ظباء أو بقر وحشية .
وخلت هذه اللوحة الطللية من التشبيهات المعهودة ، سواء فيما يتعلق بآثار الديار، أو ببقاياها. ولكنها اشتملت على كثير من العناصر التقليدية مثل : ذكر أسماء الأماكن ، والعطف بينها بالفاء ، وتحديد مكان الطلل تحديداً جغرافياً دقيقاً ، والسؤال عن أهله الظاعنين . وأسهب في وصف ما غير معالمه ، وبخاصة الأمطار ، وإن كان قد أغفل ذكر الرياح التي تسفي عليه التراب . فقد انقضى فصل الصيف وأخذت السماء تتلبد بالغيوم ، واكفهرَّ الجو ، وحمحم البرق في أرجاء وادي العقيق ، فامتزج بحنين الإبل التي نتجت في الصيف ، وما لبث البرق أن أومض ، فانهمر المطر غزيراً على تُربان وهضبة الجماء ، فأسفر عن سيل عظيم يتدافع ماؤه ، ويقتلع كل ما يعترض طريقه من الأشجار . وكان ذلك إيذاناً برحيل القوم عن تلك الأماكن بعد أن قضوا فيها فصل الربيع . وهنا تبدأ اللوحة الثانية ، لوحة الظعن . وهي لوحة تتحول إلى مشهد يبدأ بصورة صوتية للحي تسمع فيها أصوات الرجال تتعالى، فينادي بعضهم بعضاً ، في هزيع الليل الأخير استعداداً للرحيل ، ثم ينقلنا إلى صورة بصرية تظهر فيها الهوادج وقد استوت على عجل فوق ظهور الإبل ، تزينها البسط الموشاة بالألوان الزاهية ، ومدّت الظعائن أعناقاً
ومع أن حساناً قد أتى في هذه اللوحة على أكثر عناصر مقدمة الظعن ، من : وصف الاستعداد للرحيل ، ووصف الهوادج ، وما تكللت به من أنماط وبرود ملونة ؛ وحدّد نهاية الرحلة وغايتها ، إلا إنه أغفـل ذكر الحادي والدليـل، وتجنب وصـف الطريق التي سلكتها الرحلة ، ولم يتتبع الركب ، كما كان يفعل سواه من شعراء المرحلة الثانية من الشعر الجاهلي ، ممن وصفوا الظعن. قال حسان :
تَنَادَوْا بِلَيْلٍ فاسْتَقَلَّتْ حُمُولُهـُمْ
وَعَالَيْنَ أَنْماطَ الدِّرَقْلِ المُرَقّمَـا
عَسَجْنَ بِأَعْنَاقِ الظِّباءِ وأَبْـرَزَتْ
حَواشِي بُرُودِ القِطْرِ وَشْياً مُنَمْنَما
فَأَنَّى تُلاَقِيهَا إذَا حَلَّ أَهْلُهَــــا
بِوادٍ يَمَانٍ مِنْ غِفَارٍ وأسْلَمَـــا
تَلاقٍ بعيدٌ واختلاَفٌ مِنَ النَّــوَى
تَلاَقيكُما حتى تُوافيَ مَوْسِمَـا
سَأُهْدِي لَهَا في كُلِّ عَامٍ قَصِيدةً
وَأَقْعُدُ مَكْفِيَّاً بِيَثْرِبَ مُكْرَمَــا
واللوحة الغزلية ، وإن كانت أبياتها قليلة ، إلا أنهـا لا تقل شأناً عن لوحتي الطلل والظعن . فالمرأة هي باعث التجربة في نفس الشاعر ، وشعثاء التي فتنته بعينيها الحوراوين ، قد تيمت فؤاده . وبانقضاء فصل الربيع ، انطوت صفحة اللقاء ، وحل الهجر محل الوصل ، وأزف زمن الرحيل ، وحالت المسافات بين الشاعر وبين فاتنته شعثاء ، وبعدت بينهما الشقة ، بعد أن حلّت بوادٍ يمان . ولن يتمكن من ملاقاتها إلا في الموسم القادم . وخلال زمن الفراق الطويل ، سيعكف على نظم الشعر ، وإهدائه لها ، ولن يغامر أو يخاطر بالرحيل إلى منازلها . إنه سينظم الشعر فيها ، وهو في مأمن من الأخطار والمتاعب ، مكفيّ الحاجات بيثرب ، ويؤثر العافية .
وواضح أنّ حساناً قد ألمّ في هذه اللوحة ببعض عناصر المقدمة الغزلية التقليدية وأعرض عن بعض ، وانحرف ببعض .
فوصف جمال صاحبته، ولكنه اكتفى من ذلك بذكر عينيها الحوراوين ، ولم يتتبع محاسنها ومظاهر جمالها الحسي أو النفسي.
وعبّر عن افتنانه بها ، وحسرته على فراقها ، والإحساس بثقل وطأة هجرها على نفسه ؛ ولكنه بدا متعقلاً متزناً ، يكبح جماح الهوى ، ولا يغامر في سبيله ، بل يستمع لنداء العقل ، ويؤثر أن يترجم عن مكنون نفسه ، ولواعج حبه بالشعر .
وواضح أن هذا الموقف يحمل بعض ملامح التطور في المقدمة الغزلية ، فقد انحرف الشاعر فيه عما نعهده في تلك المقدمة وفي شعر الغزل عامة من تهافت على المرأة ، واندفاع ومغامرة ، وتجاوز للحراس ، والمعشر ، وتعرض للقتل ، في سبيل الوصول إليها ، على نحو ما يصوره امرؤ القيس في معلقته ، حيث يقول (96) :
تَجَاوَزْتُ أَحْرَاسَاً إِليْها وَمَعْشَراً
عَلَيَّ حِراصَاً لَوْ يُسرُّونَ مَقْتَلِي
انحرف عن ذلك إلى هذا الهدوء والاتزان الذي أشرنا إليه ، والتسامي بعواطفه إلى التعبير الفني عنها وحسب ، بدلاً من السعي إلى إشباعها في أرض الواقع :
سأُهْدي إِليْها كلَّ عامٍ قَصِيدةً
وأَقْعُدَ مَكْفِيَّاً بِيَثْرِبَ مُكَرَمَا
الصورة السادسة : المقدمة الطللية الغزلية الوصفية
وهذه صورة أخرى من صور المقدمات في قصائد حسان الجاهلية ، حشد فيها الشاعر أربع لوحات ، هي : اللوحة الطللية ، واللوحة الغزلية ، واللوحة الخمرية ، ولوحة الناقة ؛ فجاءَت حافلة بالألوان والأطياف . وتمثل هذه الصورة ، مقدمة قصيدته الميمية المقيدة التي مطلعها (97) :
مَاهَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامْ
وَمَظْعَنُ الحَيِّ وَمْبْنَى الخِيَامْ
وهو يستهلها باللوحة الطللية التي اقتصر فيها على ذكر بعض آثار الديار ، من نؤي قد تثلمت حوافه ، وبقايا علامات حائلة لمواضع خيام الحي ، ومنازلهم؛ مكتفياً من تحديد موضع ذلك الطلل بذكر أنه واد من أودية تهامة ، وبالإشارة إلى ما غير معالمه ، وطمس آثاره ، من طول العهد ، وتقادم الزمن ، إذ يقول بعد المطلع :
والنُّؤْيُ قَدْ هَدَّمَ أَعْضَادَهُ
تَقَادُمُ العَهْدِ بِوَادٍ تَهَامْ
وواضح أن التكثيف في لوحة الطلل عند حسان قد بلغ منتهاه ، فلم يذكر الشاعر سـوى قليل مـن عناصر المقدمة الطللية ، على نحو من الإيجاز الشديد ، وأعرض عن ذكر سائر العناصر والتقاليد ؛ فحين ذكر ما غير الديار اقتصر على تقادم العهد ، ولم يأت على ذكر الريـاح والأمطار ؛ وحين عرض لبقايا الديار ، اكتفى بذكر النؤي ، وتنكب ذكر ما سواه من أثاف ، ورماد ، ودمن وأوتاد . وخلت اللوحة من التشبيهات المعهودة في اللوحة الطللية .
وينقلنا حسان إلى اللوحة الغزلية ، وفيها يعترف بأن الواشين حققوا ما سعوا إليه ، فتبدلت شعثاء بوصلها هجراً ، ورثت حبال الود بينها وبينه ، فغدا لا يراها إلا في المنام ، إذ تعذرت رؤيتها في اليقظة . ثم يصف جمال صاحبته سالكاً إليه سبيل التصوير ، فيرسم لها صورة فاتنة إذ يشبهها بظبية مُطفل ، ترتعي مع خشفها سفوح جبل برام ، ويختار لها مشهداً فاتناً ، إذ يجعلها ترنو إليه نظرة إشفاق وحنو ؛ لأنه ما يزال صغير السن قليل الحيلة ، فاتر الطرف ، متقارب الخطو ، ضعيف الصوت .
ثم يقف عند موضع الفتنة من شعثاء ، ثغرها الذي يشبه رضابه ماءً بارداً سلسلاً ، ينسكب من بين صخور جبل ، فيحفر في أصله ، ليتجمع في حوض تراصفت حجارته وتقاربت ، وعلاه غمام كثيف ، فيقول :
قدْ أدْرَكَ الوَاشُون مَا حَاوَلوا
فالحَبْلُ منْ شَعْثَاءُ رَثُّ الزِّمَامْ
جِنِّيَّةٌ أَرَّقَنِي طَيْفُهَــــــــــا
تَذْهَبُ صُبْحَاً وتُرَى في المَنَـامْ
هَلْ هِيَ إلاَّ ظَبْيَةٌ مُغْــــــــزِلٌ
مَأْلَفُها السِّدْرُ بِنَعْفَيْ بَـــــرَامْ
تُزْجِي غَزَالاً فَاتِراً طَرْفُــــهُ
مُقَارِبَ الخَطْوِ ضَعيفَ البَغَامْ
كأنَّ فَاهَا ثَغَبٌ بَــــــــــارِدٌ
في رَصَفٍ تحت ظلالِ الغَمَـامْ
وواضح أن حساناً قد ضمن هذه اللوحة أغلب عناصر المقدمة الغزليةالتقليدية ، وهو إن فاته وصف مشهد الوداع المعهود في المقدمة التقليدية، إلا إنه استعاض عنه بحديث الواشين . وأجاد حين خلع على صاحبته صورة الظبية المطفل ، ووقف عند ثغرها ورضابها ، حيث لم يكتف من الصورة بالإجمال ، بل أخذ يستقصي جوانبها ، ويتتبع جزئياتها ، ويولّد في معانيها ، حتى بلغ من ذلك كل ما أراد من التعبير عن شدة افتتانه بها .
وينتقل حسان بالقارئ إلى اللوحة الثالثة من مقدمته ، اللوحة الخمرية ، التي أتى بها على سبيل الاستطراد في وصف رضاب صاحبته ، كما فعل الأعشى في مقدمة قصيدته التي مطلعها (98) :
أَلَمَّ خَيَالٌ منْ قُتَيْلَةَ بَعْدَمَا
وَهَى حَبْلُهَا منْ حَبْلِنَا فَتَصرَّمَا
حيث جاء بلوحة الخمر لتصوير الأثر الذي تركه طيف صاحبته ( قتيلة ) في نفسه عندما ألمّ به فقال :
فَبِتُّ كأَنّي شَارِبٌ بَعْدَ هَجْعَــــــــةٍ
سُخَامِيَّةً حَمْرَاءَ تُحَسَبُ عَنْدَمَـا
إِذَا بُزِلَتْ مِنْ دَنِّها فَاحَ رِيحُهَــــــا
وَقَدْ أُخْرجَتْ مِنْ أسودِ الجَوْفِ أدْهَمَا
لَهَا حَارِسٌ مَا يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْتَهَا
إِذَا ذُبِحَتْ صَلّى عَلَيْهَا وَزَمْزَمَــا
ومضى في وصفها .
وفي هذه اللوحة يزعم حسان أن رضاب صاحبته ليس ألذ من الماء الزلال فحسب ؛ بل أشهى منه ، وإن مزج بصبهاء معتقة في بيت رأس ، اعتنى بها صاحبها ، وبالغ في حفظها والحرص عليها عاماً بعد عام ، مؤملاً أن تعود عليه بربح وفير ، ومعلقاً عليها آمالاً عظاماً في ثراء عريض ؛ فإذا ما شربت دبت في عروق شاربها دبيب صغار النمل في الرمل المستوى اللين ، وسرى الفتور في مفاصله وعظامـه ، إنها صهباء من خمر بيْسان ، يسعى بها ساق أعجمي ، مدّهن بالطيـوب ، يعتمـر قلنسوة طويلة ، متوقد النشاط ، سريع الاستجابة لمن يدعوه ، لا يثنيه عن خدمته شيء ، يقول ، حسان (99) :
شُجَ بِصَهْبَاءَ لَهَا سَــــــــوْرَةٌ
مِنْ بيْتِ رَأْسٍ عُتِّقَتْ في الخِتَامْ
عَتَّقَهَا دَهْرَاً رَجَا بِرِّهَــــــــا
يُولي عَلَيْها فَرْطَ عَامٍ فَعَــــــامْ
تَدِبُّ في الجِسْمِ دَبِيبَاً كَمَا
دَبَّ دَبىً وَسْطَ رِقاقٍ هَيَــــــــامْ
مِنْ خَمْر بَيْسَانَ يُغَالَى بِهـا
دِرْيَاقَةٌ تُسْرِعُ فَتْرَ العِظَــــــامْ
يَسْعَى بِها أَحمَرُ ذُو بُرْنُسٍ
مُخْتَلَقُ الذِّفَرَى شّدَيدُ الحِـزَامْ
أَرْوَعُ لِلدِّعْوَةِ مُسْتَعْجِـــــــلٌ
لَمْ يَثْنِهِ الشَّأْنُ خَفِيفُ القِيامْ
وصورة الساقي الرشيق في مقدمة حسان هذه ، تذكرنا بصورته في مقدمة قصيدة الأعشى السابقة الذكر ؛ وإنْ كان الأعشى قد أضاف إلى وصف الخمرة والساقي ، وصف الكؤوس ، والأباريق ، والورود ، والرياحين ، والمغنى ، وآلات الطرب والندماء والظرفاء .
ومهما يكن من أمر ، فإن دراسة مقدمات حسان الجاهلية ، تكشف عن حقيقة أن الأعشى ، وعمرو بن كلثوم ـ إنْ صح أنه استهل معلقته بوصف الخمر (100) ـ ليسا الشاعرين الجاهليين اللذيـن استهلا بعض قصائدهما بوصف الخمر فحسب ، بل يشاركهما في ذلك حسان .
وبذلك يتبين أنه لا مسوّغ لقول الدكتور حسين عطوان (( إن الشعر الجاهلي كله ـ فيما نعلم ـ يخلو خلوا تاماً من قصائد بل من قصيدة واحدة افتتحت بوصف الخمر )) (101) .
علماً بأن الدكتور عطوان عاد فاعترف بأنّ للأعشى مقدمة خمرية ، فقال في الصفحة التي ورد فيها قوله السابق : (( آية ذلك أن ديوان الأعشى… لا نظفر فيه بمقدمة خمرية إلا مقدمة قصيدته الخامسة والخمسين )) (102) . وفي الوقت نفسه يغفل الدكتور عطوان لوحة حسان الخمرية الآنفة الذكر .
وفي اللوحة الرابعة لوحة الناقة يهيب الشاعر بنفسه أن يتناسى ذكر شعثاء التي حققت مآرب الواشين ، فقطعت حبل الوصال ، بالارتحال على ظهر ناقة ضخمة قوية ، طويلة ، وافرة النشاط ، واسعة الخطو ، عقيم ، لا تكف عن تحريك رأسها وعنقها من فرط نشاطها ؛ ولا يقلل من سرعتها ، أو يحد من نشاطها وحيويتها اشتداد الحر ، وارتفاع السراب وقت الظهيرة حتى يغطي قمم الآكام يقول حسان (103) :
دَعْ ذِكْرَهَا وَانْمِ إِلى جَسْرة
جُلْذِيّةٍ ذَاتِ مَرَاحٍ عَقَـــــــامْ
دِفِقَّةِ المِشْيَةِ زَيَّافَـــــــــةٍ
تَهْوِي خَنُوفَاً في فُضُولِ الزِّمَامْ
تَحْسِبُها مَجْنُونةً تَغْتَلِــي
إِذ لَفَّعَ الآلُ رُءوسَ الأَكَـــــامْ
وقد يقول قائل : إن وصف الناقة ليس جزءاً من المقدمة، وإنّ مقدمة القصيدة قد انتهت بنهاية اللوحة الثالثة ، وإن عبـارة ( دع ذا ) التي استهل وصف الناقة دليل على أنه فرغ من المقدمة ودلف إلى غرضه ، ذلك لأن العرف الشعـري عند العرب قد جـرى على أن يقولوا عند فراغهم من المقدمة : ((دع ذا ، وعدّ عن ذا ، ويأخذون فيما يريدون )) (104) .
والرد على ذلك أن أغلب النقاد يعدون وصف الناقة والرحلة عناصر أساسية من المقدمة التقليدية .
ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور حسين عطوان الذي يقول معلقاً على ما ظنه مقدمة لقصيدة النابغة الذبياني الرائية السابقة الذكر: (( ومن الطريف أن مقدمتها التي وصف فيها الأطلال ، وصاحبته ، ورحلته في الصحراء، وناقته ، ومنظراً من مناظر الصيد تبلغ ما يقرب من خمسين بيتاً ))(105) . وواضح أنه يدرج وصف الرحلة في الصحراء ، والناقة ، في صميم المقدمة التقليدية ، بل يضيف إلى المقدمة لوحة أخرى هي وصف مناظر الصيد .
ومنهم الدكتور يوسف خليف الذي يربط القسم الذاتي من القصيدة الجاهلية ، المتمثل في المقدمة التقليدية ، بحل مشكلة الفراغ في حياة الجاهليين . ويجعل حديث الشاعر الجاهلي عن الخروج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد عنصراً أساسياً من عناصر المقدمة (106) . وهو يرى أنّ القصيدة الجاهلية تنحل إلى قسمين أساسيين :
قسم ذاتي : يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ؛ ويصور فيه عواطفه ومشاعره وانفعالاته . وهو قسم نستطيع أن نضع فيه هذه المقدمات ، وما يتصل بها من وصف الرحلة والصحراء .
والقسم الآخر غيري : يتحدث فيه الشاعر عن قبيلته أو يعرض للمدح أو الاعتذار .
إلى أن يقول : (( ومن هنا نستطيع أن نتبين السر في حرص شعراء الجاهليــة على هذه المقدمات ، وما يتصل بها من وصف الصحــراء والرحلة ))(107).
وإلى مثل ذلك يذهب الدكتور وليد قصاب إذ يقول : (( فالمعروف أن القصيدة القديمة … كانت تقوم على تعدد الأغراض . فالشاعر يفتتحها بالوقوف على الأطلال ، والحديث عنها ووصفها ، ثم يعرض بعضاً من مناحي فتوته كالغزل ووصف الخمر . وقد يصف لنا رحلته في الصحراء ليعرض من خلال ذلك للحديث عن ناقته والفلاة الواسعة التي قطعها ؛ ثم يمضي إلى الغرض الأصيل من القصيدة ، فيمدح أو يفتخر أو يعاتب )) (108) .
ويؤكد ذلك الدكتور محمد عبدالعزيز الكفراوي وهو يعلل حرص الشعراء الجاهليين على تضمين مقدمات قصائدهم وصف الناقة والصحراء فيقول : (( فهم يستعيدون بذكر الناقة والصحراء عصر المخاطرة والفتوة والشباب الذي تركوه وراء ظهورهم ، وهو لذلك جزء مكمل لما بدأه الشاعر من الحديث عن عواطفه وذكرياته أثناء الحديث عن المرأة )) (109) .
ولابن رشيق القيرواني كلام حاسم في هذه المسألة ساقه في باب المبدأ والخروج والنهاية ، فقال : (( والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفارز ، وما أنضى من الركائب ، وما تجشم من هول الليل وسهره ، وطول النهار وهجيره ، وقلة الماء وغؤوره ، ثم يخرج إلى مدح المقصود ، ليوجب عليه حق القصد ، وذِمَامَ القاصد ، ويستحق منه المكافأة )) (110) .
وهذا غيض من فيض من آراء النقاد الذين نظروا إلى وصف الناقة والرحلة في الصحراء على أنه جزء لا يتجزأ من المقدمة.
ثم أن النظرة الشاملة للقصيدة تبدد أي شك في أن المقدمة لم تنته بنهاية اللوحة الثالثة ؛ ذلك لأن الغرض الرئيس للقصيدة هو الفخر الذي يبدأ بعد نهاية لوحة الناقة ، بقوله :
قَوْمِي بَنُو النَّجَّارِ إنْ أَقْبَلَتْ
شَهْبَاءُ تَرْمِي أَهْلَهَا بِالْقَتَام
وليس قوله( دع ذا) في أول اللوحة الرابعة دليلاً على أنه قد وصل إلى غرضه ؛ وإنما هو إشارة إلى أنه انتهى من لوحة ليشرع في لوحة أخرى من لوحات مقدمته . ومعنى ذلك أن حساناً قد خرج في مقدمته هذه على العرف الشعري الجاهلي ، وتمرد على تقليد من تقاليد المقدمة .
ويذهب الدكتـور حسين عطـوان إلى أنّ للمقدمة الطللية ثلاثة أشكال لاتتعدّاها إلى غيرها ، هي : صورة الطلل بمفردها، وصورة الطلل مع صاحبته ، وصورة الطلل والظعن (111) .
ولكن يتبين في ضوء دراسة مقدمات حسان الجاهلية أن تقسيم الدكتور عطوان السابق يحتاج إلى مراجعة ، إذ يبدو جلياً أن صور المقدمة الطللية تتجاوز الأشكال التي حددها الدكتور عطوان إلى أشكال أخرى ، مثل : المقدمة الطللية الظعنية الغزلية (الصورة الخامسة)، وهي التي تضم لوحة الطلل، ولوحة الغزل ، ولوحة الظعن . كما يجد القارئ في قصيدة حسان الميمية التي مطلعها (112) :
أَلَمْ تَسْألِ الرَّبْعَ الجَديدَ التَّكَلُّمَا
بِمَدْفَعِ أَشْدَاخٍ فَبُرْقَةَ أَظْلَمَا
والمقدمة الطللية الغزلية الوصفية ( الصورة السادسة ) التي تتألف من : لوحة الطلل ، واللوحة الغزلية ، واللوحة الوصفية الخمرية ، ولوحة الناقة ، كما هو الحال في مقدمة القصيدة التي نحن بصددها .
الصورة السابعة : مقدمة الطيف والرحلة
مقدمة الطيف من المقدمات الثانوية التي لم يكثر منها الشعراء في العصر الجاهلي ، فهي قليلة الورود ، محدودة المعاني ، لم يتوسع الشعراء فيها (( بل كرّروا نفس المعاني والجزئيات في إيجاز شديد )) (113) .
وفيها يتحدث الشاعر (( عن طيف الحبيبة الذي يخترق أستار الظلام ، ويسري في ظلمات الليل ، ليزور الشاعر في أحلامه ، فيؤرقه ويعيده إلى ذكريات ماضية ، ويثير في نفسه مشاعر الشوق والحنين الكامنة في أعماقه ، ويجسم إحساسه بالبعد والحرمان )) (114) .
وقد يضيف بعض الشعراء إلى ذلك تعجبهم من اهتداء الطيف إليهم ، وقطعه المفاوز حتى ألم بهم (115) .
يقول الشريف الرضي ( ت سنة 436هـ ) : (( وتعجب الشعراء كثيراً من زيارة الطيف على بعد الدار ، وشط المزار ، ووعورة الطريق ، واشتباه السبل ، واهتدائه إلى المضاجع من غير هاد يرشده ، وعاضد يعضده ، وكيف قطــع بعيداً المسافــة بلا حافر ولا خف في أقرب مدّة ، وأسرع زمان ))(116) .
وقد ذكر الدكتور يوسف خليف أن من أصحاب مقدمات الطيف في العصر الجاهلي بشامة بن الغدير ، وتأبط شراً ، وعمرو بن الأهتم (117) . وأضاف الدكتور عطوان إليهم المخبل السعدي ، وخفاف بن ندبة (118) . ولم يذكر أي منهما حسان في هذا المجال .
وتسهم في تشكيل هذه الصورة من مقدمات حسان الجاهلية لوحتان : لوحة الطيف ، ولوحة الرحلة . وبهذه الصورة افتتح حسان قصيدته الرائية التي مطلعها (119) :
حَيِّ النَّضِيرَةَ رَبَّةَ الخِدْرِ
أَسَرَتْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَكُنْ تَسْرِي
وهو يستهلها بلوحة الطيف ، حيث يوجه تحيته إلى صاحبته ( النضيرة ) ربة الخدر ، التي زاره طيفها ليلاً ، وهو نائم ؛ على الرغم من صدّها وهجرها في اليقظة ، ثم يبدي استغرابه من اهتداء ذلك الطيف إليه ، على الرغم من بعد الشقة ، ونأي المسافات ، وتوغل الشاعر وصحبه في البيداء ، ونزولهم في مكان مقفر موحش . قال حسان بعد المطلع :
فَوَقَفْتُ بِالبَيْدَاءِ أَسْأَلُهَا
أَنّى اهتَدَيْتِ لِمَنْزلِ السَّفْر
ثم ينقلنا إلى اللوحة الثانية ، لوحة الرحلة ، وفيها يصف رحلته في الصحراء وهي رحلة شاقة ، طال فيها السفر ، واشتد الحر ، وأدرك المطايا الإعياء فكف السَّفْر عن زجرها ، وأرخوا أعنتها ، إشفاقـاً عليهـا ، لما لمسوه فيها من الإنهاك والإرهاق ، بعد أن انبرى لحمها ، واستبان لهم ضمورها .
لقد ظل الشاعر وصحبه في تلك الرحلة يصرون على مواصلة السير ، حتى في وقت القيلولة ، حين تتوسط الشمس في كبد السماء ، على الرغم من ثقل ذلك على نفوسهم ، وشدّة إحساسهم بطول النهار ؛ على إبل نجيبة ، ضامرة سريعة ، موائل الرؤوس من جذب الأزمة ، تتدفق نشاطـاً وحيويـة ، وتعطي أقصى ما تستطيع من قدرة عن طواعية ، دون حاجة إلى زجر أو حث ، لا يعيقها عن السير في لفح الهواجر عائق ، فتراها تزفر في بُرى النحاس المعلقة في مناخرها . وإذا ما أناخت للراحة في منزلة من منازل الطريق ، تراها كالقطا الجثم التي اختلط سوادها بصفرة . وما تلبث أن تنهض مستأنفة سيرها ، تحت وقد الظهيرة ، في الوقت الذي يرتفع الحرباء على عوده ، ويهم بالحركة ، ويتعالى صرير الجنادب ، يقول حسان :
وَالعِيسُ قَدْ رُفِضَتْ أَزِمَّتُها
مَمَّا يَرَوْنَ بِهَا مِنَ الفَتْـــرِ
وَعَلَتْ مَسَاوِيها مَحَاسِنَهَـا
مِمَّا أَلَحَّ بِهَا مِنَ الضُّمْــــرِ
حتّى إِذَا رَكَدَ النَّهارُ لَنَا
نَغْتَالُهُ بِنَجَائبٍ صُعْـــــــرِ
عُوجٍ نَوَاجٍ يَعْتَلِينَ بِنَا
يُعْفَين دًونَ النَّصِّ والزَّجْــرِ
مُسْتَقْبِلاتٍ كُلَّ هَاجِـرَةٍ
يَنْفُخْنَ فِي حَلَقٍ مِنَ الصُّفْرِ
وَمُنَاخُهَا في كلِّ مَنْزِلَةٍ
كَمَبِيتِ جُونيِّ القَطَا الكُدْرِ
وَسَمَا عَلى عُودٍ فَعَارَضَنَا
حِرْبَاؤُهَا أَوْ هَمَّ بِالخَطْــــرِ
وَتَكَلُّفِي اليَوْمَ الطَّويلَ وَقَدْ
صَرَّتْ جَنَادِبُهُ مِنَ الظُّهْـــــرِ
ومن الواضح أن حساناً قد ضمن لوحة الطيف في هذه المقدمة معظم العناصر التقليدية التي ذكرها الشريف الرضي ، والدكتور خليف والدكتور عطوان لتلك اللوحة ، ولكن على نحو من الإيجاز والتكثيف .
وبقدر ما أوجز في لوحة الطيف أسهب في لوحة الرحلة ، فأفاض في وصف طولها ، وما لحق المطايا من أين وكلال ؛ وأفاض في وصف ظواهر الطبيعة القاسية ليصل بالرحلة إلى أقصى غاية من الصعوبة ، وليضاعف شحنة الاستغراب من قدرة الطيف على قطع المسافات التي قطعها الشاعر وصحبه ، وهو الضعيف الذي ليس في قدرته ذلك .
الصورة الثامنة : مقدمة وصف الليل والظُّعن
تتضافر على تكوين هذه الصورة من صور مقدمات حسان الجاهلية لوحتان ، هما : لوحة وصف الليل ، ولوحة الظعن .
ومقدمة وصف الليل من المقدمات القليلة (( التي لم يحرص الشعراء على افتتاح قصائدهم بها كثيراً )) (120) .
وقد افتتح حسان بهذه الصورة قصيدته البائية التي مطلعها (121) :
تَطَاولَ بالخَمَّانِ لَيْلِي فَلَمْ تَكَدْ
تَهُمُّ هَوَادِي نَجْمِهِ أَنْ تَصَوَّبَا
فاستهلها بلوحة وصف الليل ، وفيها يشكو من هم ثقيل يلقي عليه بجرانه ، ويجثم على صدره ، فيجعله يحس بأن الليل بالخمان أطول مما عهده بكثير ، فيحاول أن يقطعه بمراقبة النجوم ، والتلهي بعدها ، ومتابعة حركتها ، حتى لكأنه موكل بها ؛ أو كأنما قطع على نفسه عهداً بألا يخلد إلى النوم حتى يتأكـد من غياب آخر نجم منها . وقد أبت تلك النجوم الحركة ، حتى إن أوائلها لا تغيب أبداً ، فضلاً عن أواخرها . وها هو ذا يراقب حركتها البطيئة ، وقد جفا النوم عينيه ، ويتابعها نجما نجما ، فيهيأ له أنها إبل مُعيِيَة يظلع بعضها في إثر بعض .
ولا يلبث الشاعر أن يكشف عن سبب ذلك الهم الثقيل الذي يحول بينه وبين النوم ، فإذا بـه الخوف من فراق صاحبتـه المفاجئ ، أو مباغتة قومها له بالرحيل ، يقول حسان بعد المطلع :
أَبيتُ أُرَاعيَها كَأَنّي مُوَكَّــــلٌ
بِهَا ما أُرِيدُ النَّوْمَ حتَّى تَغَيَّبَـــــا
إِذَا غَارَ مِنْهَا كَوْكَبْ بَعْدَ كَوْكَــبٍ
تُرَاقِبُ عَيْنِي آخِرَ الَّليْلِ كَوْكَبَــــا
غَوَائِرَ تَتْرَى من نُجُومٍ تَخَالُهَا
مَعَ الْصُّبْحِ تَتْلُوهَا زَوَاحِفَ لُغَّبَــــا
أَخَافُ فَجَاءَاتِ الفِراقِ ببَغْتَـــةٍ
وَصَرْفَ النَّوَى من أنْ تُشِتَّ وَتَشْعَبَا
وهموم حسان الثقيلة ، وليله الطويل الذي لا تتحرك نجومه نحو المغيب ، تذكرنا بهموم النابغة ، وليله ، ونجومه . في بعض مقدماته التي وصف فيها الليل .
وتسلمنا لوحة وصف الليل وتداعياتها في مقدمة حسان السابقة إلى لوحة الظعن . وقد رأيناه يختم الأولى بإبداء مخاوفه من فجاءَات الفراق ، وصروف النوى . فإذا به يستهل الثانية بتأكيد أن مخاوفه قد تحققت ، فقد أخذ رجال الحي في تقويض الخيام ، وزمّ الأمتعة ، استعداداً للرحيل ؛ وتعالت أصواتهم تنبئ عن وشك الفراق ، وارتفع الصوت المشؤوم ، صوت الغراب ينعب من على غصن شجرة بانٍ قريبة ، منذراً باغتراب الأحبة وبَيْنِهِم ، فأيقن الشاعر بحتمية وقوع ما كان يحذره ، وعزّز ذلك في نفسه مرور الطير عن يساره، مما ضاعف تشاؤمه .
ويكمل حسان هذه اللوحة المؤثرة بوصف أثر الفراق في نفسه ، فيبين أنّ مشهد تقويض الخيام أصابه بالذهول ، وجعله في حيرة تركت رأسه أشيب ، ودب في نفسه صراع بين العاطفة والعقل ، فقلبه يهيب به أن يمتطي ناقته ، ويخف في أثرهم ، وعقله يأمره بتوخي الاتزان .
ولا يغفل الشاعر عنصـر الزمن في هذه اللوحة ، فيحدده بوقت الأصيل، عندما أخذت الشمس تجنح نحو المغيب ، يقول حسان :
وَأَيْقَنْتُ لَمَّا قَوَّضَ الحَيُّ خَيْمَهُـــمْ
بِرَوْعَاتِ بَيْنٍ تَتْرُكُ الرّأْسَ أَشْيَبَا
وأِسْمَعَكَ الدَّاعِي الفَصِيحُ بِفُرْقَـةٍ
وَقَدْ جَنَحَتْ شَمْسُ النَّهارِ لتَغْرُبَـا
وَبيَّنَ في صَوْتِ الغُرابِ اغْتَرابُهُــمْ
عَشِيَّةَ أوْفَى غُصْنَ بانٍ فَطَرَّبَــــــا
وفي الطَّيْرِ بالعَلْيَاءِ إِذْ عَرَضَتْ لنَا
وَمَا الطَّيْرُ إِلاَّ أَنْ تَمُرَّ وَتَنْعَبَــــــا
غَداةَ انْبَرى قَلْبي يُنَازِعُهُ الهَــوَى
أنازِعُ نفْسي أنْ أقُومَ فَأرْكَبَــــــا
ومن الواضح أنّ الشاعر قد أغفل كثيراً من تقاليد مقدمة الظعن وعناصرها التي تواضع عليها من سبقوه من شعراء الجاهلية ؛ فلم يصف الإبل ، وما حملت من هوادج ، وثياب ، ولم يتحدث عن ألوانها وشياتها ، كما لم يتطرق إلى الحادي والدليل ، وحرّاس القافلة الأشداء ، ولم يلمّ بالطريق الذي ستسلكه الظعن ، وما يحفّ به من مخاطر ، وما يتناثر على جانبيه من عيون مهجورة أو صالحة ، كمـا لم يكشف عن أسباب الرحيل ، ولا عن الغاية التي ستنتهي إليها الرحلة .
وإذا كان حسان قد عدل عن كل هذه العناصر التي تُعَدُّ من مقومات مقدمة الظعن ، فإنه قد أضاف عنصراً جديداً مهماً إلى تلك المقدمة ، هو صورة الغراب ، الذي يمثل في الوجدان العربي رمز التشاؤم ، والفراق ، والبين ، كما أفاد من أسطورة (122)السانح والبارح التي كان يؤمن بها كثير من الجاهليين . وفي الوقت نفسه أسس للربط القوي بين لفظ ( الغراب ) ومعنى الاغتراب أو الغربة ، وبين لفظ ( البان ) ومعنى البين ، هذا التأسيس الذي أكثر الشعراء العرب بعده من استلهامه والنسج على منواله .
وبهذا يكون حسان قد تطوَّر بمقدمة الظعن تطوراً ذا شأن عندما وظف بعض العناصر الأسطورية ، واستعان بها في رسم جو التشاؤم والخوف محققاً بذلك تميزاً عن سابقيه ، وممهداً للتوسع في ذلك عند من جاء بعده من الأمويين وسواهم ، ولا سيما جرير الذي ردد هذا العنصر كثيراً في مقدمات الظعن التي استهل بها بعض قصائده .
وقد عرض الدكتور حسين عطوان لمقدمة الظعن في العصر الجاهلي عند نفر من الشعراء المرموقين ، مثل : المرقش ، وعبيد بن الأبرص ، وسلامة بن جندل ، وبشر بن أبي خازم ، وزهير ، والممزق ؛ وانتهى إلى تحديد أهم عناصرها ، وأبرز مقوماتها وتقاليدها (123) . وإن لم يتعرض لأحد عناصرها المهمة ، وهو غراب البين ، والتشاؤم به ، وتوقع الفراق ، ورحيل الأحبة عند نعيبه ؛ لأن العرب إنما سمّوه (( غراب البين )) (( لأنه إذا بان أهل الدار وقـع في مواضع بيوتهم ، يلتمس ويتقمقم ، يتشاءَمون به ويتطيرون منه )) (124) كما يقول الجاحظ .
وعندما عاد الدكتور عطوان إلى الحديث عن المقدمة نفسها عند الشعراء الأمويين ، وقف وقفة طويلة عند هذا العنصر (( غراب البين )) في مقدمات الظعن عند جرير الذي اتخذ الغراب رمزاً لكثير من مقومات تلك المقدمة وتقاليدها (125). وشغل به (( لما يثيره في النفوس من الخواطر ، وما يبعثه فيها من المعاني التي تتلاءَم مع مواقف التحمل ومشاهد الارتحال ، فأخذ يذيعه في مقدماته ، ويلح عليه مستعيضاً به عن كثير من أوصافها وتقاليدها )) (126) .
وعندما وازن الدكتور عطوان بين الفرزدق وجرير والأخطل ، فيما يتعلق بافتتاح قصائدهم بمقدمة الظعن ، جعل أبرز ما يتميز به جرير في ذلك المجال (( استغلال المعاني الأسطورية التي تتصل بالغراب ، والتي كانت شائعة بين العرب )) (127) .
وحديث الدكتور عطوان في هذا الموضوع بمجمله يدل على أن مقدمات الظعن قبل العصر الأموي لم تتطرق إلى ذلك العنصر ( غراب البين ) ، وإن لم ينص على ذلك صراحة . والحقيقة أن دراسة مقدمات حسان الجاهلية تكشف عن أنه سبق جريراً إلى استغلال هذا العنصر الأسطوري ، وتضمينه مقدماته الظعنية ، كما تشهد لوحته السابقة .
ولعلّ فيما يتصل بما نحن بصدده من تجديد حسان في مقدمة الظعن ما ذهب إليه الدكتور عطوان أيضاً من أن مقدمة الظعن قد ((تحولت إلى اتجاه فرعي عند الشعراء المخضرمين )) (128) . بعد أن كانت من الأشكال الأساسية للمقدمات في الجاهلية
فقد تبين من خلال دراسة مقدمات حسان الجاهلية أن لوحة وصف الظعن تحتل المركز الثالث بين اللوحات التي شكلت مقدماته ، حيث تشكل 14.28% ولها ثلاث لوحات . ولا يتقدمها سوى اللوحة الغزلية ، وتحتل المركز الأول وتشكل 33.33% ولها سبع لوحات ، واللوحة الطللية ، التي تحتل المركز الثاني وتشكل 28.57% ولها ست لوحات ، وتسبق هي لوحة الرحلة والراحلة التي تشكل 9.52% وتحتل المركز الرابع ولها لوحتــان ، ولوحة الطيف ، والخمر ، ووصف الليل ، وتحتل كل منها المركز الخامس وتشكل 4.76% ولكل منها لوحة واحدة .
والجدول الآتي يوضح ذلك :
ترتيبها نسبتها عدد مرات ورودها نوع اللوحة
المركز الأول 33.33% 7 الغزلية
المركز الثاني 28.57% 6 الطللية
المركز الثالث 14.28% 3 الظعنية
المركز الرابع 9.52% 2 الرحلة والراحلة
المركز الخامس 4.76% 1 الخمرية
المركز الخامس مكرر 4.76% 1 الطيف
المركز الخامس مكرر 4.76% 1 وصف الليل
99.98% 21 المجموع
وقد يؤكد ذلك أنّ مقدمة الظعن لم تتحول إلى اتجاه فرعي عند حسان ، فلم يتقدمها سوى لوحتي الغزل والطلل ، في حين تقدمت هي لوحات الرحلة والراحلة ، والخمر ، والطيف ، ووصف الليل . هذا فضلاً عن أنها تشكل 14.28% من مجموع لوحات المقدمات في قصائد حسان الجاهلية .
وفي ضوء هذا التحليل تظهر ضرورة إعادة النظر في حكم الدكتور عطوان السابق .
المحور الثالث : مظاهر التطور في مقدماته الجاهلية
يتبين من العرض السابق أن حساناً قد تناول في مقدماته الجاهلية معظم الاتجاهات التقليدية للمقدمات ، ما كان منها عاماً ، أو فرعياً أو ثانوياً . ولكن من الملاحظ أنه لم يستهل أيّاً من قصائده ببكاء الشباب ، أو الفروسية أو الشكوى أو الحكمة .
كما يلاحظ أن اللوحات الغزلية في مقدماته ، تفوق اللوحات الطللية عدداً ، وهـو في ذلك يخالف الرأي السائد الذي يذهب إلى أن المقدمة الطللية (( أكثر المقدمات انتشاراً في صدور قصائد الشعراء الجاهليين )) (129) .
والمتأمل في المقومات والعناصر التي اشتملت عليها مقدمات حسان الجاهلية يتبين أنه قد تخلى عن بعض العناصر التقليدية تخلياً تاماً . كما يتبين أن مقدماته تتكون من : عناصر ثابتة ، وعناصر متغيرة ، وعناصر جديدة .
فثمة عناصـر ومقومات أبقى حسان عليها ، والتزم بها في جميع مقدماته، وحافظ عليها ، وحذا فيها حذو سابقيه .
وثمة عناصر لم يلتزم بها التزاماً تاماً ، ولم يتخلَّ عنها تخلياً كلياً ، ولكن ظهرت في بعض مقدماته ، واختفت في بعضها الآخر .
وثمة عناصر جديدة ، وهي ضربان : ضرب انحرف به حسان عن مساره السابق ، وضرب من ابتكار حسان وسبقه ، وسألقي الضوء على كلّ من هذه الاتجاهات في مقدمات حسان الجاهلية مركّزاً على لوحاته الغزلية والطللية والظعنية ، وهي اللوحات الرئيسة في مقدماته الجاهلية .
أولاً ـ العناصر التي تخلى عنها :
يلاحظ الدارس أن لوحات حسان الجاهلية تخلو من بعض العناصر والتقاليد التي تعد من المقومات الرئيسة للمقدمات الطللية والغزلية والظعنية ، وفي ذلك دليل على رغبة حسان في التخلص من بعض قيودها الموروثة .
فلوحاته الطللية تخلو من استيقاف الصحب ، ومن ظهور الرفيقين معه على المسرح الطللي ، يخاطبهما ويطلب إليهما إسعاده بالبكاء . كما تخلو من وصف ما حل بالأطلال من حيوانات برية كالظباء ، والنعام ، وبقر الوحش وحمره وأتنه .
وهو لا يذكر ما ذرته الرياح على الطلل من رمال كما استقر في العرف الجاهلي ، وبالتالي تخلو لوحاته الطللية من تشبيه الرمال التي تسفيها الرياح بالدقيق المتناثر أو خلافه ، وهو تشبيه لا يكاد يغيب عن لوحة الطلل في المقدمات الجاهلية التقليدية . وفي اللوحة الوحيدة التي ذكر فيها الرياح لم يعرض للرمال التي تسفيها وإنما عرض لأوراق الشجر اليابسة التي تعصف بها ،
فقال(130) :
تَعِلُّ رِيَاحُ الصَّيْفِ بَالي هَشِيمِهِ عَلَى مَاثِلٍ كَالحَوْضِ عَافٍ مُثّلَّمِ
ويكاد حسان أن يتخلى عن عنصر مهم آخر ، بل مقوم رئيس من مقومات المقدمة الطللية ، وهو البكاء على الطلل ، فلم يقف حسان بالطلل باكياً إلا في لوحة واحدة ، وبكاؤه لم يكن على أحبته الظاعنين ، بل على أمجاد الغساسنة وعزِّهم .
وكان الدكتور يوسف خليف قد لاحظ اختفاء عنصر البكاء على الأطلال في مقدمات زهير ومدرسته ، وأن زهيراً (( يقف بالأطلال هادئاً رزيناً ، يرى الحب وفاءً صامتاً ، وأحزاناً تطويها الأعماق ، لا دموعاً تفيض من العينين حتى تبلّ محامل السيف ))(131) . كما هو شأن امرئ القيس .
ومعنى ذلك أن حساناً قد سار على نهج زهير ومدرسته لافي التخلي عن البكاء فحسب ، بل في اختفاء الرفيقين عن مسرح الطلل . بل تجاوز زهيراً ومدرسته فتخلى عن استيقاف الصحب ، ووصف ما حل بالأطلال من حيوانات الصحراء ، وعن ذكر ما ذرته الرياح على الطلل من رمال .
وتخلو لوحاته الغزلية من وصف مشاهد الوداع والرحيل ، وما تثيره في نفس الشاعر من حزن ولوعة ، وحنين وأسى ، كما تخلو مما نجده عند سابقيه من حرص على تبيان محاسن صواحبهم ، وتتبعها غير تاركين شيئاً منها . فحسان ـ كما يبدو في لوحاته الغزلية ـ ليس من شعراء الغزل الذين يشفُّهم الهوى ، فيذوبون شوقـاً ولوعة . وربما يؤيـد سائر شعره ما نذهب إليه ، فهو يكثر من الفخر بقومه وبنفسه أمام المرأة ، بل يصرح بأنه لن يخاطر أو يغامر في سبيل زيارتها إذا ما نأت دارها ، وشط مزارها ، ويعلن أنه سيكتفي بنظم الشعر وإهدائه لها ، وينتظر لقاءَها في الموسم القادم . انظر إلى قوله : (132)
سَأُهْدِي إِلَيْها كُلَّ عَامٍ قَصِيدَةً وَأَقْعد مَكْفِيَّاً بِيَثْرِبَ مُكْرَمَا
ثانياً ـ العناصر الثابتة :
وهي العناصر التي تشبث بها حسان ، فظهرت في جميع لوحاته ، وهي قليلة إذا ما قيست بالعناصر المتغيرة . وقد يحمل هذا إشـارة أخـرى لنزوع حسان إلى التحرر من المقومات الموروثة للمقدمة التقليدية . والعناصر الثابتة في لوحات حسان الطللية ثلاثة ، هي : مساءَلة الطلل عن أهله الراحلين ، واسترجاع ذكرياته به ، ووصف ما يحف به من وحشة وإقفار .
وأما لوحاته الغزلية ، فهو لم يتمسك فيها إلا بعنصر ثابت واحد ، وهو الحديث عن عواطفه ، وما يحس به من وجد ، وسهد ، وحنين تجاه صاحبته . وتمسكه بهذا العنصر ليس تاماً . فهو في لوحته الغزلية التي تضمنتها مقدمة قصيدته النونية ، التي مطلعها : (133) .
لِمَنِ الدَّارُ أَوْحَشَتْ بِمَعَانِ بَيْنَ أَعْلَى اليَرْموكِ فَالخَمَّانِ
لم يكشف عن شيء من عواطفه .
وليس في لوحاته الظعْنيَّة أيّ عنصر ثابت . وأما لوحته الخمرية فيحتفظ فيها بصورة الساقي الرشيق ، فحسب . وأما في لوحة الطيف فيتمسك بقدر أكبر من العناصـر الموروثة ، مثل : التعجب من اهتداء الطيف إليه ، وقطع المفاوز المهلكة ، وزيارته في صحراء نائية .
ثالثاً ــ العناصر المتغيرة :
وهي العناصر التي تظهر في بعض لوحاته ، وتختفي في بعضها الآخر ، تبعاً لعوامل لا يمكن حصرها ؛ أو الوقوف عليها ؛ وفي مقدمتها الحالة النفسية والتجربة الشعرية ، والموقف الانفعالي أو الشعوري الذي يعيشه الشاعر عند نظم قصيدته ، وطبيعة الشاعر الفنية . ومن هنا كان من الطبعي أن تختلف هذه العناصر من شاعر لآخر ، ومن قصيدة لأخرى عند الشاعر نفسه ، في التفاصيل والجزئيات ، وحضور بعض العناصر وغيابها ، (( وهو اختلاف لا بد منه في الأعمال الفنية ، وإلا فقدت هذه الأعمال أهم عنصر فيها وهو التعبير عن الشخصية )) (134) .
والعناصر المتغيرة في لوحات حسان الطللية كثيرة ، هي : ذكر أسماء المواضع ، والعطف بينها بالفاء ، وتحديد مكان الطلل ، وذكر ما تبقى من آثـار الديار ، وما غيرهـا من عوامل الطبيعة ، أو تقادم الزمن ، وتشبيه بقاياها بالثوب الموشى أو الوشم أو آثار الكتابة المطموسة أو غير ذلك ، وتشبيه الأثافي بالحمائم الجثم ، أو الملتفة حول فرخ لها .
وهي في لوحاته الغزليـة التغني بجمال المرأة الحسي أو المعنوي أو بهما معاً ، واسترجاع ذكرياته معها ، والتحسر على أيامه الماضية ، فضلاً عن التصريح بذكر اسمها .
وفي لوحة الظعن ، وصف الاستعداد للرحيل ، ووصف الإبل وهوادجها ، والطريق الذي سلكته القافلة ، وما يحف به من مخاطر ، وما تناثر على جانبيه من رمال وعيون ، وذكر المكان الذي انتهت إليه رحلة الظعائَن ، وسبب الرحيل ، والحديث عن غراب البين ، رمز التشاؤم .
رابعاً ــ العناصر الجديدة في مقدمات حسان :
لم يقتصر نزوع حسان إلى التحرر من قيود المقدمة التقليدية على التخلي عن بعض مقوماتها ، بل تعداه إلى محاولات تجديدية تتمثل في إضافة عناصر جديدة إلى تلك المقدمة ، أو الانحراف بالعناصر التقليدية الموروثة إلى عناصر يستوحي فيها حياته الخاصة ، وتجاربه الذاتية .
وكانت مقدمة القصيدة قد انتهت إلى حسان وطبقته وهي تحمل كثيراً من بصمـات مدرسة الصنعة وطوابعها التي تتمثل في عدد من التقاليد ، من : (( عناية بالتفاصيل والجزئيات ، وجنوح إلى التعبير بالصورة ، وحرص على استكمال عناصرها ، وخطوطها ، وألوانها ، ووضع اللمسات الفنية الأخيرة عليها ، واهتمام بانتقاء الألفاظ واختيارها ، وإحكام لصياغة العبارات ، وبراعة في توليد المعاني الدقيقة ، والغوص خلف الأفكار العميقة )) (135) .
والمتأمل في مقدمات حسان الجاهلية يجد أنه لم يحرص على هذا الإرث الفني ، بل تمرد عليه ، في أكثر مقدماته ؛ فمال إلى التركيز والتكثيف بدل العناية بالجزئيات والتفاصيل ، والألوان ، والظلال . ويبدو ذلك واضحاً في قصيدته اللامية التي مطلعها : (136) .
أَسَأَلْتَ رَسْمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ تَسْأَلِ
بَيْن الجَوَابِي فَالبُضَيعِِ فَحَوْمَلِ
وربما تبدو هذه الظاهرة أوضح ما تبدو (137) في قصيدتــه العينية التي مطلعها (138) :
بَانَتْ لَمِيْسُ بِحَبْلٍ مِنْكَ أَقْطَاعِ
واحْتَلَّتِ الغَمْرَ تَرْعَى دَارَ أشْرَاعِ
كما تظهـر بوضوح في لوحة الطلل من مقدمة قصيدته الميمية المقيدة التي مطلعها : (139) .
مَا هَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامْ
وَمَظْعَنُ الحَيِّ وَمَبْنَى الخِيَامْ
حيث تصل هذه الظاهرة إلى أوجها .
ويلمس المتأمل في مقدمات حسان الجاهلية ميل حسان الواضح إلى الاقتصاد في التعبير بالصورة الشعرية في أكثر مقدماته ، حتى ليمكن القول إن ذلك من الملامح المميزة للمقدمة عنده ، بخلاف زهير ومدرسته . وتكفي هنـا الإشارة إلى قصائده : الميمية ، واللامية ، والطائية ، حيث جرى الحديث بالتفصيل عن ذلك في أثناء عرض صور مقدماته .
ويجد الدارس ـ فضلاً عن ذلك ـ كثيراً من مظاهر الجدة في مقدمات حسان الجاهلية إذا ما قيست عناصرها ومقوماتها بتلك التي كانت سائدة في مقدمات سابقيه . كما يجد مظاهر أخرى للانحراف ببعض عناصر المقدمـة ومقوماتها نحو التعبير عن معان وأحوال تتصل بحياة حسان ، وظروفه ، وتجاربه الذاتية ، منها :
أولاً : إكثاره من ذكر أماكن تقع خارج الجزيرة العربية . فقد ردد حسان في مقدماته كثيراً ذكر مواضع تقع في ديار الغساسنة ، كالذي ـ يجده القارئ في قصائده : اللامية(140) ، والنونية (141) ، والدالية (142) .
ثانياً : تعبيره عن الإعجاب بأمجاد الغساسنة وعزّهم ، في مواضع كان سابقوه يعبرون فيها عن أشواقهم، وصبواتهم إلى المرأة، كما نجد في لوحته الطللية التي افتتح بها قصيدته النونية .
ثالثاً : قد لا يثير وقوفه بالأطلال في نفسه صورة الظعن ومراكب النساء ، وإنما يدفعه إلى استعادة صورة قنابل الخيل ، وكرائم الإبل عند الغساسنة ، كما في قصيدته النونية سالفة الذكر .
رابعاً : لا يذكر حسان في بعض لوحاته الطللية الأحبة الظاعنين ، ولا يستعيد ذكريات الحب ، أو يشكو تباريح الهوى ، وإنما يستعيد ذكرياته في ديار الغساسنة ، ويشيد بسالف عزّهم ، كما في قصيدته اللامية .
خامساً : قد ينحرف حسان في بكائه عن نهج السابقين ، فلا يبكي الأحبة الغائبين ، بل يبكي قومه الغساسنة . انظر إليه يقول : (143)
فَالعَيْنُ عَانِيةٌ تَفِيضُ دُمُوعُهَا
لِمَنازِلٍ دَرَسَتْ كَأَنْ لَمْ تُوءَلِ
دَارٌ لِقَوْمٍ قَدْ أَرَاهُمْ مَــــــرَّةً
فَوْقَ الأَعِزَّةِ عِزُّهُمْ لَمْ يُنْقَلِ
سادساً: سبق الحديث عن تخلي حسان عن فكرة الرفيقين في لوحاته الطللية. ولكننا نجده يخاطب شخصين في مقدمة قصيدته الطائية ،
فيقول (144) :
بَلِّغَاهَا بِأَنَّنِي خَيْــــــــرُ رَاعٍ
لِلَّذِي حَمَّلَتْ بِغَيْرِ افْتِـــــراطِ
والمخاطبان هنا ليسا الرفيقين التقليديين اللذين يظهران عادة في مسرح الطلل وإنما شخصان عاديّان يطلب إليهما الشاعر أن يبلغا رسالة عنه ، وواضح أنه انحرف بفكرة الرفيقين هنا عن خطها السابق .
سابعاً: لا يبدي حسان في لوحاته الغزلية تهافتاً على المرأة ، فهو لا يخاطر بنفسه أو يتجشم الصعاب في سبيل الوصول إليها ، كما نجد عند كثير من شعراء الجاهلية ، وإنما يتسامى بمشاعره أحياناً فيجعل التعبير الفني عنها بديلاً عن محاولة إشباعها ، ويمثل ذلك قوله في ختام مقدمة قصيدته الميمية (145) :
سَأُهْدِي لَهَا فِي كُلَّ عامٍ قَصِيدَةً
وَأَقْعُدُ مَكْفِيّاً بِيَثْرِبَ مُكْرَمَا
ثامناً : ومن الجديد في لوحات حسان الغزلية التي تتضمنها مقدماته الجاهلية أنه يصف الجواري والولائد اللاتي كان يشاهدهن في بلاط الغساسنة أو في ديارهم ، في أثناء زياراته لهم ؛ فيثـرن إعجابه ، كالذي نقـرأه في لوحته الغزليـة التي تضمنتها قصيدته النونية ، من قوله (146) :
قَدْ دَنَا افِصْحُ فَالوَلاَئُدُ يَنْظِمْنَ
(م) قُعُودَاً أَكِلَّةَ المَرْجَانِ
ومما يحمل بعض ملامح الجدة في تلك اللوحة أن حسان لم يتغن فيها بجمال المرأة الجسدي أو النفسي ، كما هو الحـال في المقدمات الغزليـة عند الجاهليين، وإنما عبر عن انبهاره بالمرأة الحضرية ، وأدوات زينتها ، وعطورها ، ولباسها ، وهو انبهار حدا به إلى تفضيل المرأة الحضرية على البدوية . يقول :
يَجْتَنِينَ الجَادِيَّ في نُقُبِ الرَّيْطِ
(م) عَلَيْهَا مَجَاسِـــــــدُ الكَتَّانِ
لَمْ يُعَلَّلْنَ بِالمَغَافِرِ والصَّمْـــــغِ
(م) ولا نَقْفِ حَنْظَلِ الشَّرْيَانِ
تاسعاً : ولعل من الجديد الذي رصده البحث في لوحات حسان الغزلية مزج مشاعره وموصوفاته ببعض عناصر الطبيعة ، أو اتخاذ الطبيعة خلفية لبعض المواقف ، كما في لوحته الغزلية التي تضمنتها قصيدته الدالية ، حيث يختار لصاحبته ( شعثاء ) عندما يستعيد ذكراها وقتاً تلبس فيه الطبيعة أزهى حللها ، يقول (147) :
تَذَكُّرُ شَعْثَاءَ بَعْدَ الكَـــــــرَى
وَمُلْقَى عِرَاصٍ وَأَوْتَادَهَا
إِذَا لَجِبٌ منْ سَحَابِ الرَّبيـــعِ
مَرَّ بِسَاحَتِها جَادَهَــــــا
ويرسم لوجهها صورة لا أبهى ولا أجمل ، صورة وجه الغزال الذي غذي بأطيب نبات ، وأينعه ، ورعى الأماكن التي لا تطؤها الأقدام ، فيقول :
وَوَجْهَاً كَوَجْهِ الغَزَالِ الرَّبِيبِ
يَقْرُو تِلاعاً وأَسْنَادَهَــا
فَأَوَّبَهُ اللَّيْلَ شَطْرَ العَضَــــاهِ
يَخَافُ جَهَامَاً وَصُرَّادَها
عاشراً : ومن أهم ملامح الجدّة في لوحات حسان الظعنية استغلاله لبعض العناصر الأسطورية في الحياة الجاهلية ، مثل : الغراب ، والسانح ، والبارح ، في رسم جو الحزن والتشاؤم الذي يصاحب استعداد أحبته للرحيل ، كما يبدو في قصيدته البائية ،حيث يقول (148) :
وَبَيَّنَ فِي صَوْتِ الغُرَابِ اغْتَرابُهُـمْ
عَشِيَّةَ أَوْفَى غُصْنَ بَانٍ فَطَرَّبَا
وَفِي الطَّيْرِ بِالعَلْيَاءِ إِذْ عَرضَتْ لَنَا
وَمَا الطَّيْرُ إِلاَّ أَنْ تَمُرَّ وَتَنْعَبَا
مما يجعله سابقاً لجرير وسواه من الأمويين والعباسيين الذين توسعوا في استغلال تلك العناصر .
حادي عشر : ومن تلك الملامح الجديدة أن عبارة ( دع ذا) في شعر حسان قد لا تعني أنه فرغ من المقدمة ، ودلف إلى غرض القصيدة ، كما هو الشأن عند شعراء الجاهلية ؛ بل تعني أنه فرغ من لوحة من لوحات مقدمته ليشرع في لوحة أخرى ؛ كما يجد من يتأمل مقدمة قصيدته الميمية التي افتتحها بقوله(149):
مَا هَاجَ حَسَّانَ رُسُومُ المَقَامْ
وَمَظْعَنُ الحَيِّ وَمَبْنَى الخِيَامْ
هذه بعض ملامح الجدة التي رصدها البحث في مقدمات حسان . ولعل محمد بن سلام الجمحي قد نظر إليها ، وإلى ما تخلى عنه حسان وسواه من شعراء الحواضر العربية ؛ عندما أطلق عليهم لقب ( شعراء القرى العربيـة ) ، ليميزهم من شعراء البوادي الذين التزموا تلك المقومات ، وتقيدوا بها ، ولم يخرجوا عنها .
وفي ضوء ذلك يظهر عدم وجاهة النقد الذي وجهه الدكتور حسين عطوان لابن سلام ، حين قال منكراً عليه صنيعه هذا : (( ولسنا ندري لماذا أفرد ابن سلام بابا خاصاً بشعراء القرى العربية : مكة ، والمدينة ، والطائف ، والبحرين ، واليمامة ، مع أنه لم يستخرج من أشعارهم خصائص فنية معينة تميزهم من شعراء البوادي ، ولا نصّ على الدافع الذي حمله على ذلك سوى ملاحظته أنّ الشعر يكثر في البوادي ، ويقل في الحواضر )) (150) .
فالنظرة العميقة المتأنية إلى مقدمات حسان الجاهلية تكشف دون شك عن خصائص غير التفاوت في كثرة الشعر وقلته ، ميزت شعر حسان من شعر سواه من شعراء البوادي ، وتبين أن في مقدماته الجاهلية ملامح جديرة بالالتفات إليها ، والوقوف عندها .
الحواشي والتعليقات
(1) انظر : الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية ، السهيلي 2/280 وقد شكك السهيلي رحمه الله في البيت السابع وهو :
على أنيابها أو طعم عض من التفاح هصّره اجتناء
وبنى شكه على أساس فني حيث قال : (( والبيت موضوع لأنه لا يشبه شعر حسان ولا لفظه )) . وقد آثرت أن أستبعد من البحث كل ما تطرق إليه الشك .
(2) انظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحـ محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الجيل، بيروت 1/188 ـ 189 .
(3) المصدر السابق 1/231 .
(4) هي عمرة بنت خالد بن عطية بن حبيب بن عمرو بن عوف الأوسية . انظر : ديوان حسان تحـ حنفي ص :191 .
(5) ديوانه تحـ حنفي ص : 191 وتحـ عرفات 1/307 وأراد يدهن القلب فأدخل اللام والصرم : الهجر ، وابتكر: عجّل، والإدهان: الخضوع ، والمصانعة ، والحصر : الضيق .
(6)المصدر السابق .
(7)انظر: الأغاني 2/160 ـ 161 وانظر ديوان حسان تحـ عرفات 1/230 ـ 331 .
(8) ديوان حسان تحـ حنفي ص : 194 وتحـ عرفات 1/230 .
(9) المصدر السابق تحـ حنفي ص : 131 و تحـ عرفات 1/25 .
(10) السابق .
(11) السابق .
(12) هو صيفي بن عامر الأسلت ، ويكنى أبا قيس ، كان قائد الأوس يوم بعاث ، لم يدخل الإسلام ، وكان شاعراً مجيداً . انظر : تاريخ التراث العربي ، لسزكين ، م2 ج2 ص 307 .
(13) البويلة : موضع بالمدينة التقى فيه الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فكانت الدائرة فيه على الأوس ، فقال حسان القصيدة : انظر ديوانه تحـ عرفات 1/243 .
(14) ديوان حسان تحـ حنفي، ص : 319 ود. عرفات 1/243 وأراد بالرسول : الرسالة . أي إذا ألقى إليه أبو قيس سمعه يبين له ما فيه .
(15) العمدة 1/231 .
(16) المصدر السابق .
(17) نفسه 2/151 .
(18) هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها أخذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة ، وله كتب مصنفة ، توفي سنة 206هـ . الفهرست ص : 140 .
(19) هو دريد بن معاوية (الصمة) كان سيد بني جشم بن معاوية (هوازن ) وكان من ألد أعداء النبي e ، قتل يوم حنين ورثته أخته عمرة ، ويعد في الشعراء المعمرين . انظر الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ص 470 ـ 473 ، تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين ، م2 ، ج2، ص : 273 ، وتاريخ الأدب العربي ، فروخ 1/231 .
(20) العمدة 2/151 .
(21) المصدر السابق .
(22) يوسف خليف ، دراسات في الشعر الجاهلي ، ص : 120 .
(23) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص :109 .
(24) مختار الشعر الجاهلي ، مصطفى السقا ، طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط2 1948 ص : 176 .
(25) انظر : ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، دار المعارف ط6 ، ص : 586 ، 588 .
(26) انظر : جمهرة أشعار العرب ، طبع بيروت سنة 1963م ص 112 .
(27) مقدمة الققصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 109 .
(28) المرجع السابق .
(29) نفسه .
(30) نفسه .
(31) العمدة 1/231 .
(32) الشعر الجاهلي مادته الفكرية وطبيعته الفنية، نشر مكتبة الشباب، القاهرة ص : 351 .
(33) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 109 .
(34) السابق .
(35) طبقات فحول الشعراء تحـ محمود شاكر ، مطبعة المدني ، ص : 25 .
(36) المصدر السابق ، ص : 25 والخصائص لابن جني طبع دار الكتب ص : 386 .
(37) انظر : علي الجندي : تاريخ الأدب الجاهلي ، ط2 1966م مكتبة الجامعة العربية ، بيروت جـ 1 ص : 34 ، وشوقي ضيف ، العصر الجاهلي ، ص : 178 .
(38) ناصر الدين الأسد ، ص : 586 .
(39) انظر: ناصر الدين الأسد، ص: 587 وقد نقل ذلك عن سركيس في معجم المطبوعات.
(40) انظر تفاصيل ذلك الخلاف في مصادر الشعر الجاهلي ، ص : 585 ، 586 ، 587 .
(41) المرجع السابق ، ص : 585 ، 586 .
(42) المرجع السابق ص : 585 ، 586 ، 587 وعلي الجندي ، 1/234 .
(43) السابق ، ص : 585 .
(44) السابق ، ص 586 .
(45) السابق ، ص : 585 .
(46) نفسه ، ص : 587 وانظر علي الجندي 2/234 .
(47) نفسه ، ص : 586 .
(48) نفسه .
(49) نفسه ، ص : 584 .
(50) نفسه .
(51) انظر : علي الجندي ، ص : 232 .
(52) ابن النديم ، الفهرست ، ص : 82 .
(53) أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص : 49 .
(54) ابن جني ، الخصائص ، ط الهلال 1913 ، ص : 3/311 .
(55) انظر : عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، ص : 96 .
(56) هي القصائد ذوات الأرقام : 71 ، 228 ، 70 ، 56 ، 39 ، 29 ، 10 من تحقيق حنفي و23 ، 150 ، 10 ، 18 ، 136 ، 4 ، 26 من تحقيق عرفات .
(57) هي القصيدة رقم 72 من تحـ حنفي و8 من تحـ عرفات .
(58) هي القصيدة رقم 7 من تحـ حنفي و3 من تحـ عرفات .
(59) هي القصيدة رقم 218 من تحـ حنفي و 123 من تحـ عرفات .
(60) هي القصيدة رقم 38 من تحـ حنفي و 27 من تحـ غرفات .
(61) 23.8 على وجه التحديد .
(62) 24.63 على وجه التحديد .
(63) خطمة ( بفتح أوله ، وسكون ثانيه ) موضع في أعلى المدينة . ويوم خطمة من أيام الأوس والخزرج قتل فيه حصين بن الأسلت. انظر: ديوان حسان تحـ حنفي ص: 332 وتحـ عرفات 1/300 ومعجم البلدان تحـ فريد الجندي جـ2 ص 433 .
(64) سبق التعريف به .
(65) ديوان حسان تحـ حنفي ص : 332 والمفضليات ، تحـ أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة السابعة ، ص : 284 .
(66) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 335 .
(67) هذه العبارة سبقت أغلب تلك القصائد في تحـ حنفي .
(68) هذه العبارة سبقت أغلب تلك القصائد في تحـ عرفات .
(69) وردت هذه العبارة في التمهيد للقصيدة رقم29تحـ حنفي،وفي التمهيد للقصيدة رقم 4 في تحـ عرفات .
(70) ديوان حسان تحـ حنفي ص : 322 وتحـ عرفات 1/255 .
(71) المصدر السابق تحـ حنفي ، ص : 335 وتحـ عرفات 1/302 .
(72) يوسف خليف ، دراسات في الشعر الجاهلي ، ص : 144 .
(73) المرجع السابق ، ص : 123 .
(74) حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، دار المعارف بمصر، 1970م ص : 117 .
(75) طبقات الشعراء ، مطبعة بريل ، ليدن 1913م ، ص : 52 .
(76) عطوان ، ص : 116 .
(77) خليف ، دراسات ، ص : 125 .
(78) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 121 وتحـ عرفات 1/74 .
الجابية ( بكسر الباء وياء مخففة ) : قرية من أعمال دمشق من عمل الجيدور من ناحية الجوْلان قرب مرج الصفَّر في شمالي حوران . معجم البلدان 2/106 .
والبُضيع ( مصغر ، ويروى بالفتح في هذا البيت ) : جبــل بالشام أسود معجم البلدان 1/525 .
وحومل ( بالفتح ) : موضع . معجم البلدان 2/373 .
ومرج الصُفَّر ( بالضم وتشديد الفاء) : بدمشق ، أو على أربعة فراسخ منها .
معجم البلدان 5/118 وديوان حسان تحـ عرفات 2/74 .
جاسم : قرية بطرف الجوْلان ، بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق إلى طبرية . معجم البلدان 2/109 .
وتبنى ( بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر ) : بلدة بحوران من أعمال دمشق . معجم البلدان 2/16 .
والمدجنات : الأمطار الغزيرة . والعانية : سائلة بالدمع .
(79) خليف ، ص : 133 .
(80) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 167 وتحـ عرفات 1/91
وبواط ( بالضم وآخره طاء مهملة : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى . معجم البلدان 1/596 وفي ديوان حسان تحـ حنفي ص 168 موضع والغطاط : ضرب من القطا شبه الأثافي بها .والألوف : جمع إلف وهو الأليف . وابن عمرو : يعني نفسه نسبها إلى جده الرابع ، فهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو . انظر : ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 61 والشَّطاط : البعد ، واللجاج : الخصومة . والافتراط : التضييع والتفريط .
(81) خليف ، ص : 111 .
(82) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 136 .
(83) خليف ، ص : 147 .
(84) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 136 .
(85) ديوان حسان ، تحـ حنفي ص 102 وتحـ عرفات 1/113 . وملقى عراص وأوتادها أي الموضع الذي كانوا ينزلونه ويعترضون فيه . والمغدودن : الشعر الكثير الطويل ، وتنوء : تنهض ، وآدها : أثقلها .
والتلاع : مسايل الماء إلى الأودية ، وأسناد الجبل : ما قابلك منه واحدها سند . والعضاه : كل شجرة ذات شوك فهي عضة ، وشطرها : نحوها . والصّراد : السحاب الذي لا ماء فيه يكون مع شدة برد الريح .
(86) المصدر السابق تحـ حنفي ، ص : 335 وتحـ عرفات 1/302
وأقطاع : منقطع . والغمر : اسم لمياه عديدة ، والماء الكثير . ودار أشراع من شرع الوارد إذ تناول الماء بلا ضم . والإمراع : الخصب . والغروب : الدلاء العظيمة ، وإتراع: امتلاء .
(87) خليف ، ص : 124 ـ 125 .
(88) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص 123 .
(89) خليف ، ص : 125 .
(90) ديوان حسان ، تحـ حنفي ، ص : 180 وتحـ عرفات 1/62 والخياعيل واحدها خيعل . والخيعل والخيلع واحد وهو : ثوب يجاب وسطه شبيه بالإتب أو البقير . أو قميص بلا كمين تلبسه النساء ، أو برد يشق ويلبس بلا كمين ، وهو الرهط . والسابري : منسوب إلى سابور . ومرسم : معلم ، وريْط : جمع ريْطة وهي كل ملاءَة غير ذات لفقين كلها نسج واحد ، وقطعة واحدة . أو كل ثوب لين رقيق . ومباديه : ظواهره . والركد : أراد الأثافي . والشجيج : أراد الوتد . والسحيق : الثوب الخلق . والمنمنم : المزخرف . الهشيم: ما جف من الشجر . والماثل : أراد النؤى الدارس والجون : السحاب الأسود ، والساري : الماطر ليلاً ، والوابل : أشد المطر وقعاً وأعظمه قطراً . والمتهزم المتشقق بالماء . الودق : المطر ، والمنبجس : المتفجر ، وتزجيه : تسوقه . وضعيف العرى : سريع الصب ، وبركه : صدره . والداني : الثقيل . والمسف من ثقله . والأكظم : الممتلئ. والأسحم : الأسود . والكاشح : المتولى عنك بوده . الرث: البالي . المتجذم : المتقطع . كظَّ : امتلأ حتى ضاق . والنث : نشر الحديث وإذاعته ، ومرجم : غير يقين .
(91) المصدر السابق ، تحـ حنفي ص : 322 وتحـ عرفات 1/255 ومعان ، ( بالفتح وآخره نون ) : مدينة في طرف الشام ، تلقاء الحجاز ، من نواحي البلقاء ، معجم البلدان 5/179 ويرموك واد بناحية الشام من طرف الغور ، كانت به المعركة المشهورة بين المسلمين والروم ، معجم البلدان 5/497 والخمان ( بفتح أوله وتشديد ثانيه ) : من ناحية البثنية من أرض الشام . معجم البلدان 2/444 وبلاس ( بالفتح والسين المهملة ) : بلد بينه وبين دمشق عشرة أميال . معجم البلدان 1/564 .
وداريّا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة . معجم البلدان 2/492 وسكاّء ( بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، والمد ) : قرية بينها وبين دمشق أربعة أميال في الغوطة . معجم البلدان 3/259 . وجاسم ( بالسين المهملة ) : اسم قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق الأعظم إلى طبرية . معجم البلدان 2/109 والفصح : عيد النصارى . ويجتنين : يلتقطن . والجادي : الزعفران .
والنقب: جمع النقبة وهي : ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيق . والمجاسد : جمع مجسد كمبرد: ثوب يلي الجسد. والمغافير: صمغ الثمام واحده مغفور ، والشريان : شجر .
(92) عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 137 .
(93) ديوان حسان تحـ حنفي ص: 149 وتحـ عرفات 1/279
وجلّق ( بكسرتين وتشديد اللام وقاف ) : اسم لكورة الغوطة كلها ، وقيل : بل هي دمشق نفسها . وقيل جلق موضع بقرية من قرى دمشق . معجم البلدان 2/179 . والبلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان ، معجم البلدان 1/580 وشعثاء هذه بنت عمرو بن ماسكة من يهود ، وكانت مساكن بني ماسكة بناحية القف ، وكان أبو شعثاء قد رأس اليهود التي تلي بيت التوراة ، وكان ذا قدر فيهم . ديون حسان تحـ عرفات 2/208 والمحبس : موضع . والسند : سند الجبل سفحه . وبصرى
( بالضم والقصر ) : من أعمال دمشق وهي قصبة حوْران . معجم البلدان 1/522 والريْط: جمع الريْطة : وهي الملاءَة . والقدد : القطع واحدتها قدة . والمخيسات : الإبل المذللة وسربح : واسع ، والجدد : المستوي .
(94) انظر:عناصر مقدمة الظعن.عطوان،مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي،ص:137.
(95) ديوان حسان تحـ حنفي ص 125 وتحـ عرفات 1/34 . والرسم ما على وجه الأرض من الآثار . والقاع : الأرض المستوية . والجزع : منعطف الوادي . وتتهم : أتى أهله تهامة وتركوه . والنقيع (بالفتح ثم الكسرة وياء ساكنة وعين مهملة ) : من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة ، على أربعة برد . معجم البلدان 5/348 وانظر : ديوان حسان . وتغلم ( بالفتح ثم السكون وفتح اللام ) : جبل ، وهما تغلمان بين نخل وبين الطرف دون المدينة بمرحلة ، وأفردهما للضرورة. معجم البلدان 2/41 وديوان حسان . والمراض ( بفتح الميم ) : واد فوق التغلمين من أرض غطفان . والمراضان واديان . معجم البلدان 5/108 والحور شدّة بياض العين في شدّة سوادها . والترب : اللدة والصديقة، النشاص: سحاب ينشأ في عرض السماء منتصباً . وإرزامة :رعده ، وأعضاده : نواحيه ، وتحمحمه : صوته. والمطافيل : الإبل معها أولادها أطفالاً . والرباع جمع رُبَع وهو ما نتج في الربيع . وأثجم : سال . والعقيق : وادي المدينة . والجماء: هضبة ، ووئيد الرعد : شدة صوته . والقاؤه بركه : مقامه لا يبرح ، وتهزمه تشققه بالماء ، والبرك : الصدر : وتربان : بالقرب من العقيق ، والتلعة : مسيل الماء إلى الوادي. والعضاه :كل شجر له شوك ، الواحدة عضة . والدرقل : ضرب من الثياب .
وعسجن : مددن أعناقهن . والقطر : ضرب من برود اليمن . أو ثياب حمر . غفار : ابن مليل من كنانة . وأسلم : ابن أفصى بن حارثة من خزاعة منازلهم بتهامة وهي من ناحية اليمن .
(96) أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات تحـ عبدالسلام هارون ، دار المعارف بمصر ، ط2 ، ص: 49 .
(97) ديوان حسان تحـ حنفي، ص: 184 وتحـ عرفات 1/106 وأعضاد الحوض نواحيه . والنسبة إلى تهامة : تهامي وتهام بالفتح . وظبية مغزل : ذات غزال والنعف : ما انحط من الارتفاع ، وارتفع عن الانحطاط . وبرام ( بكسر أوله وفتحه ) : جبل في بلاد بني سليم عند الحرّة من ناحية البقيع . معجم البلدان 1/436 . وتزجي: تسوق . وبغمت الظبية: صوتت بأرخم ما يكــون صوتها . والثغب ما سال من الجبل فحفر في أصله . والرصف : الحجارة المتراصفة المتقاربة .
(98) ديوان الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس ، شرح وتعليق د. محمد محمد حسين ، الناشر مكتبة الآداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية ص : 293 .
(99) شج : مزج ، وبيت رأس : قرية بالأردن. معجم البلدان 1/616 . وبرها : أراد ثمنها ، ويولي : يحلف من الأليّة . الرقاق : الرمل المستوي الناعم . وبيسان ( بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون ) : مدينة بالأردن بالغور الشامي ، بين حوران وفلسطين . معجم البلدان 1/625 . ودرياق : شفاء . والذفريان : عن يمين النقرة وشمالها . والبرنس : قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام .
(100) انظر أسباب الشك في هذه المقدمة ، في : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ،
ص: 171 .
(101) المرجع السابق .
(102) نفسه .
(103) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 186 وتحـ عرفات 1/106 وجسرة : ناقة ضخمة طويلة، ذات مراح : نشيطة ، عقام : عقيمة ، جلذية : صلبة . دفقة : واسعة الخطو . خنوف : تخنف برأسها وعنقها من النشاط . اغتلت الدابة : تجاوزت حسن السير . والاغتلاء : الإسراع . لفها : غشاها .
(104) العمدة 1/239 .
(105) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 109 .
(106) انظر : دراسات في الشعر الجاهلي ، ص 106 .
(107) المرجع السابق ، ص : 117 ـ 118 .
(108) قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ، ص : 218 ـ 219 .
(109) الشعر العربي بين الجمود والتطور ، ص : 38 .
(110) العمدة 1/226 .
(111) انظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 121 ـ 126 .
(112) ديوان حسان تحـ حنفي ص : 125 وتحـ عرفات 1/34 .
(113) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 168 .
(114) خليف ، دراسات ، ص : 168 .
(115) انظر : مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي ، ص : 165 .
(116) طيف الخيال ، تحـ حسن كامل الصيرفي ، طبع دار إحياء الكتب العربية،سنة1962م ، ص: 16 .
(117) خليف ، ص : 168 .
(118) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 168 .
(119) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 187 وتحـ عرفات 1/52 والسفر : المسافرون . وركود النهار : طوله. ونغتاله : نقطعه . والصعر : الموائل من جذب الأزمّة . والعوج : الضمر. والنواجي :السراع . والجون من القطا : المائلة إلى السواد ، والكدر : إلى الصفرة . وخطر الحرباء : تحركه .
(120) مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي ، ص : 168 .
(121) ديوان حسان ، تحـ حنفي ، ص : 148 وتحـ عرفات 1/116 . وخمان ( بفتح أوله وتشديد ثانيه ) : من نواحي البثينة من أرض الشام . معجم البلدان 2/444 . وتترى : تتابع . جنحت : مالت . وغوائر : جمع غائر من غار النجم إذا غاب . لغب : معيبة ، أعياها السير . والنعيب : صوت الغراب .
(122) استعمل الباحث لفظ (الأساطير ) بمعناه اللغوي الذي حددته معاجم اللغة وهو : الأحاديث لا نظام لها جمع إسطار ، وإسطير بكسرهما ، وأُسطور وبالهاء في كل . كما جاء في القاموس المحيط ( سطر ) والأساطير : الأباطيل ، وواحد الأساطير : أسطورة . لسان العرب ( سطر ) .
(123) انظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلية ، ص : 137 ـ 138 .
(124) الجاحظ ، الحيوان ، تحـ عبدالسلام هارون ، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1938م جـ2 ص 315 .
(125) مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، ص : 83 .
(126) السابق .
(127) السابق ، ص : 85 .
(128) مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، ص : 76 .
(129) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 116 .
(130) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 181 وتحـ عرفات 1/62 .
(131) خليف ، ص : 138 .
(132) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 138 .
(133) السابق ، ص : 322 .
(134) خليف ، ص : 169 و125 .
(135) السابق ، ص : 133 .
(136) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 121 وتحـ عرفات 1/74 .
(137) سبق الحديث بالتفصيل عن ذلك في مواضعه أثناء عرض صور المقدمات .
(138) ديوان حسان تحـ حنفي ، ص : 335 وتحـ عرفات 1/300 .
(139) المصدر السابق تحـ حنفي ، ص : 184 وتحـ عرفات 1/106 .
(140) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 121 وتحـ عرفات 1/74 .
(141) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 322 وتحـ عرفات 1/255 .
(142) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 149 وتحـ عرفات 1/279 .
(143) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 122 وتحـ عرفات 1/74 .
(144) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 168 وتحـ عرفات 1/91 .
(145) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 128 وتحـ عرفات 1/34 .
(146) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 322 وتحـ عرفات 1/255 .
(147) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 102 وتحـ عرفات 1/113 .
(148) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 148 وتحـ عرفات 1/116 .
(149) نفسه ، تحـ حنفي ، ص : 184 وتحـ عرفات 1/106 .
(150) مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، ص : 116 .
المصادر والمراجع
1 ـ الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأموي ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، القاهرة ( د.ت) .
2 ـ الأعشى : ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير ، شرح وتعليق محمد محمد حسين ، نشر مكتبة الآداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية ، القاهرة 1950م .
3 ـ ابن الأنباري : أبو بكر محمد بن القاسم ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار المعارف ، ط2 ، 1969م .
4 ـ الجاحظ : أبو عثمان ، عمرو بن بحر بن محبوب ، الحيوان ، تحقيق عبدالسلام هارون ، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفىالبابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط1 ، 1938م .
5 ـ ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية ، ط2 ، 1952م .
6 ـ حسان بن ثابت :
ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، تحقيق وليد عرفات ، نشر دار صادر ، بيروت 1974م .
ـ ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق سيد حنفي حسنين ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 ، 1983م .
7 ـ حسين عطوان :
ـ مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، دار المعارف بمصر ، 1974م .
ـ مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ، دار المعارف بمصر ، 1970م .
8 ـ ابن رشيق: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط5 ، 1401هـ/1981م .
9 ـ سزكين : فؤاد ، تاريخ التراث العربي ، ترجمة محمود فهمي حجازي ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 1403هـ /1983م .
10 ـ ابن سلام : محمد بن سلام الجمحي:
ـ طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ،1974م .
ـ طبقات الشعراء ، مطبعة بريل ، ليدن 1913م .
11 ـ السهيلي : أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلـي ، الروض الأنف في تفســير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام ، القاهرة ، 1914م .
12 ـ أبو الطيب اللغوي : عبدالواحد بن علي ، مراتب النحويين ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، 1974م .
13 ـ علي الجندي: تاريخ الأدب الجاهلي، مكتبة الجامعة العربية ، بيروت ، ط2 ، 1966م.
14 ـ عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2 ، 1388هـ / 1969م .
15 ـ الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب بن محمد ، القاموس المحيط ، ترتيب الطاهر أحمد الزاوي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط3 ، (د. ت) .
16 ـ القرشي : أبو زيد بن أبي الخطاب ، جمهرة أشعار العرب ، بولاق . (د. ت ) .
17 ـ محمد أبو الأنوار : الشعر الجاهلي مادته الفكرية وطبيعته الفنية ، نشر مكتبة الشباب، القاهرة ، 1936هـ /1976م .
18 ـ المرتضى : الشريف المرتضى علي بن الحسين ، طيف الخيال ، طبع دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1962م .
19 ـ مصطفى السقا : مختار الشعر الجاهلي ، طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط2 ، 1948م .
20 ـ المفضل الضبي : المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ، المفضليات ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، ط7 ، 1983م .
21 ـ ابن قتيبة الدينوري : أبو محمد بن عبدالله بن مسلم، الشعر والشعراء ، طبع ليدن 1902م .
22 ـ محمد عبدالعزيـز الكفراوي : الشعر العربي بـين التطور والجمود ، دار القلم ، بيروت ( د.ت) .
23 ـ ابن منظور : أبو الفضل ، جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت (د.ت).
24 ـ ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، دار المعارف ، ط6 ، 1982م .
25 ـ ابن النديم : أبو الفرج ، محمد بن إسحق بن يعقوب ، الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت 1398هـ /1987م .
26 ـ ياقوت الحموي : أبو عبدالله ، ياقوت بن عبدالله الرومي ، معجم البلدان ، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د.ت) .
27 ـ يوسف خليف : دراسات في الشعر الجاهلي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1981م .
28 ـ وليد قصاب: قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ، الرياض، دار العلوم1400هـ /1980م .


